العقل دينًا قراءة تحليليّة في الخطاب القرآنيّ والتراث الإسلاميّ عن علاقة العقل بالدّين والتحقُّق الروحي
تعاني ظاهرة الدين في يومنا هذا من مشاكلَ شديدة التعقيد. فعلى سبيل المثال، باتت علاقة الدين بحياة الإنسان اليوميَّة وبالسياسة غير واضحة المعالم بعد انتشار مفاهيم العلمنة والأنظمة السياسيَّة القائمة على القوانين الوضعيّة، الأمر الذي فرض على الفرد المؤمن والدولة على حد سواء تحدّيات كثيرة خاصةً بعد أن سادت أنماط حياة عصرية تختلف اختلافًا جوهريًّا عن تلك التي دعت إليها التعاليم الأساسيّة لكثير من الأديان التوحيدية الرئيسة؛ وجَعَلَ، تاليًا، التوفيق بين الاثنين أمرًا صَعْبًا، وأحيانًا مستحيلًا. وهناك أيضًا إشكاليَّة علاقة الدين بالعنف الممارس تحت راية المعتقدات الدينية المختلفة. ثمَّ هناك إشكاليّة علاقة الدين بالعلم وعلاقة الإيمان بالعقل، والشرع بالفلسفة، وهي جبهة حرب مُشتعلة منذ العصور القديمة حتى يومنا هذا.
وفي حقبة الحداثة، نجح رُوَّادُ الثورة العلمية ومفكِّرو التنوير في إرساء معادلة تقول إنَّ الإيمان والعقل هما شيئان متناقضان لا يلتقيان: فحيثُ يحضر أحدُهما يَغيب الآخر. ونجحوا في حَصْرِ عمل العقل بالعلوم الطبيعية وأعطوها وحدها القدرة على كشف حقيقة الوجود المادي، وفي حَصْرِ الإيمان بمجال الظنون والآراء الخاصة التي يرتبط بها الناس من خلال مشاعرهم اللاعقلانيَّة. ونرى اليوم أنَّ كثيرًا من القائمين على الأديان أنفسهم قد قبلوا هذه المعادلة بعد أن ترسَّخت بمرور الوقت من خلال المناهج التعليمية الحديثة والتقدُّم الـمُطَّرد للاكتشافات العلميَّة والتقنية التي لم تزل تبهر العالم بإنجازاتها الكبيرة. غير أنَّ القبول بهذه المقولة يطرح بنظري الإشكاليَّة الأخطر والتحدي الأكبر أمام الدين، لأنَّ الكتب المنزلة جعلت الحقيقة مقصد الأديان التوحيديّة الرئيس. وبالتالي، فإنّ مثل هذا الفصل لا يضرب فرعًا من فروع الدين بل أصلًا من أصوله.
بالطبع، ليس ههنا المكان للخوض في أسباب نشوء هذه الإشكاليَّة ونتائجها وأبعادها. فغرض هذا البحث هو إظهار أصالة العلاقة الموجودة بين الجانب الإنساني للدين (أي المعرفي والإيماني والمسلكي) وطبيعته العاقلة بوجهٍ عام، وليس بالجانب المعرفي أو الإدراكي منها حصرًا؛ وذلك من خلال تقديم تحليل مُركَّز للخطاب القرآني الذي جعل هذه الطبيعة مَرْكَزًا للهويّة الإنسانيّة ولأهمّ الأعمال الروحيّة المتَّصلة بجوهر التحقيق الديني، وأقصد المعرفة الإلهيّة والإيمان والأعمال الصالحة. وكيف أنَّ الخطاب القرآني، وانسجامًا مع هذا الاتجاه، جعل الدين دليلًا فعَّالًا لتحقيق الكمال الخاص بهذه الطبيعة الإنسانيَّة العاقلة بما يتضمَّنه من إرشاد معرفيّ ومسلكيّ يهدف إلى حفظها وتنميتها.
هكذا غرض يفترض إظهار مقاربة الخطاب القرآني للذات الإنسانية والحالة الوجودية المختصة بها: طبيعتها الخاصة وعلاقتها بالخالق وعلاقتها بالرسالة الإلهيّة المتمثّلة بالنص الموحى، وعلاقتها بالإرادة الإلهيّة والتي يفترض أن تتمظهر في السيرة الموافقة (أو "الطائعة" بالمصطلح الديني)، ولدور العقل من حيث هو القوة الإدراكيّة الخاصة بفهم حقائق الوجود وغيرها من الموضوعات التي تتفرع عنها أو تتصل بها. ولضيق المجال، سأعمد إلى الاقتصار على تقديم الأفكارِ الرئيسة التي تُبرز العلاقة الوثيقة بين الدين والعلم والإيمان والعقل، واستحالة الفصل بينهما، وإظهار الحجج التي أستند إليها في تحقيق هذا الغرض.
سأبدأ البحث بعرض موجز لنموذجَين بارزَين لمقاربة هذا الموضوع من التراث الإسلامي، وهما ابن رشد والغزالي، وإظهار أهمّ أبعاد نظرتهما إلى المسألة. ثمَّ أقدِّم عرضًا مُركّزًا ومختصرًا لأهمّ ما تفسّره المعاجم التراثية الرئيسة عن معاني العقل لأنتقل بعدها إلى الغرض الرئيس للبحث فأعرض أولًا لعلاقة العقلِ بالهُوية الإنسانيّة، ثمَّ علاقته بالنص المنزل من حيث هو قوة الإدراك المختصّة بالحق الذي هو غاية الوحي، ومن ثمَّ علاقة الرسالة النبوية بالعقل والطبيعة العاقلة، وعلاقة الطبيعة العاقلة بالسيرة الإنسانيّة والمصير الروحي الموعود للمؤمنين.
وقد تقصَّدت باختيار عبارة "الخطاب القرآني" في العنوان إبراز المنهج الذي سأتّبعه في إظهار ما يقوله الكتاب المنزل عن مفهوم العقل وعلاقته بالدين والإيمان. ويقوم هذا المنهج على تتبُّع المصطلحات التي تتصل بـ"العقل" بما هي قوة إدراكية بوجه خاصّ وتلك المتّصلة بالطبيعة العاقلة للإنسان بوجه عام ودراسة الروابط المعنوية (من معنى) والوظيفية التي يبنيها الخطاب القرآني فيما بين هذه المفاهيم والمصطلحات نفسها وفيما بينها وبين مفاهيم ومصطلحات أخرى تتصل بالعلم والمعرفة والإيمان وغيرها. ويندرج هذا المنهج ضمن التفسير العقلي للنص القرآني لكونه يقاربه باعتباره نصًّا يُقدِّم مفاهيم واضحة ومُتّسقة عن الموضوعات التي تندرج فيه، ومن ضمنها العقل وعلاقته بالدين والإيمان، ويتقصَّى معاني الآيات وغاياتها لا من خلال المأثور والخبر (أي النقل) بل بواسطة تحليل النصّ العقلي الممنهج.
ويهدف هذا البحث إلى تقديم صورة مختلفة، وربما مناقضة، لتلك المألوفة في أيامنا هذه عن الموضوع. وأعتقد أنَّه من المفيد للدراسات الإسلاميّة خاصةً والدينيّة عامةً إعادة الإضاءة على العلاقة العضويّة بين الاختبار الدينيّ والحالة الإنسانيّة بطبيعتها العاقلة بالعودة إلى النص الديني الأصل ودراسته بمعزلٍ عن الأطر المألوفة في التراث الإسلامي والقيود المنهجيّة والمفاهيميّة التي يشتمل عليها لما قد يساهم ذلك في فتح آفاق جديدة للأبحاث المرتبطة بالموضوع ذاته بوجه خاص والدراسات الدينيّة والقرآنيّة بوجه عام. ومن شأن هكذا دراسة أيضًا أن تقدِّم منظورًا مختلفًا للإنسان المعاصر الذي يبحث عن أطر عقليّة لفهم حقيقة العلاقة القائمة بين العلم والدين والعقل والإيمان بعيدًا عن الخطاب الديني التقليدي من جهة والمقاربات الحديثة، التصالحية منها أو الصدامية، من جهة أخرى، وذلك بتقديم مادة علميّة متّسقة ومفهومة للتفكُّر بالموضوع بأبعاده المتعدّدة في وقت بات يُشكل فيه تطوُّر العلوم الطبيعية والمناهج الاختباريّة على أنقاض المعتقدات الدينية الموروثة أحد أبرز التحديات التي تواجه استمرارية الدين في المجتمعات المدنيّة الحديثة، وينحو العالم فيه أكثر فأكثر إلى التفريق بين الدين والعقلانية وإلى مقاربة التجربة الدينية بافتراضها حالة عرضيّة على السيرة الإنسانيّة بعمقها التاريخي المديد.
نموذجان بارزان من التراث الإسلامي
درج الباحثون في العصر الحديث على مقاربة علاقة العقل بالدين والإيمان في التراث الإسلامي من خلال ما كتب مُفكران إسلاميان معروفان من العصر الوسيط عن الموضوع، وهما القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد (ت. 595هـ/1198م) والإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت. 505/ 1111م). ويُقَدَّم الأول على أنَّه يُمثِّلُ المنحى العقلي في التفسير والتشريع الديني وصديق للفلسفة والعلوم العقليّة والطبيعية، ويُقَدَّم الثاني على أنَّه النقيض الذي يُمثِّل المنحى التقليدي ومناهض للعقل والفلسفة والعلوم العقليّة والطبيعية عامةً. وسأقدّم في ما يلي عرضًا مختصرًا لمقاربتي ابن رشد والغزالي لإظهار أهم معالمهما والإشكاليّة الرئيسة التي تصدَّيا لها كنموذجين لما هو مألوف عن الموضوع في التراث الإسلامي، بهدف توضيح الخلفيّة الجدليّة للموضوع من جهة، ولبيان جدّة المقاربة التي يتضمنها هذا البحث من جهة أخرى.
خصَّص ابن رشد كتاب فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال لتوضيح أنَّ الشرع الإسلامي وخاصةً النَّص المنزل لم يُجِز استخدام المناهج العقليّة في تفسير الكتاب والعلوم الدينيّة وحسب، بل دعا إلى إعمال العقل في فهم الدين والوجود عامةً، وأوجب ذلك على المسلمين في كثير من آيات الكتاب المنزل. وقد بيّن ذلك في مقدمة كتابه المذكور، حيث قال:
فأمَّا أنَّ الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلّب معرفتها به، فذلك بَيِّن في غير آية من كتاب الله تبارك وتعالى مثل قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (الحشر/2). وهذا نصّ على وجوب استعمال القياس العقلي، أو العقلي والشرعي معًا. ومثل قوله تعالى ﴿أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ﴾ (الأعراف/185). وهذا نص بالحثّ على النظر [العقلي] في جميع الموجودات (ابن رشد، 1991، ص128).
غير أنَّه عاد وحصر جواز استخدام النظر العقلي أكان في تفسير الكتاب أو دراسة العلوم الدينيّة الأخرى بنوع خاص من الناس، وهم الذين يصلون إلى التصديق بالحقائق عن طريق البرهان، أي بواسطة العقل. فقد استنتج ابن رشد أن النصَّ القرآني قسَّم الناس إلى ثلاثة أقسام وفق طرق التصديق التي توافق طباعهم:
إنَّ شريعتنا هذه الإلهية حقّ وإنّها التي نبّهت على هذه السعادة، ودعت إليها، التي هي المعرفة بالله ومخلوقاته، فإنَّ ذلك مقرّر عند كلّ مسلم من الطريق الذي اقتضته جبلّته وطبيعته من التصديق. وذلك أن طباع الناس متفاضلة في التصديق: فمنهم من يصدّق بالبرهان، ومنهم من يصدّق بالأقاويل الجدليّة... ومنهم من يصدّق بالأقاويل الخطابيّة... (ص 34).
وقد بنى ابن رشد استنتاجه هذا على "تضمُّن شريعته طرق الدعوة إلى الله تعالى، وذلك في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل/125)" (ص 35). ووفقًا لتفسيره للآية المذكورة، فإنَّ كل طريقة من طرق الدعوة المذكورة فيها - أي الحكمة والجدل والوعظ—توافق طبعًا من طباع الناس في طرقهم في التصديق؛ وإنَّ الحكمة هي الطريقة الموافقة لطبع من يصلون إلى التصديق بالبرهان من دون غيرهم. ويحقّ لهؤلاء فقط، بل هو واجبٌ عليهم، أن يعتمدوا المنهج العقلي في تفسير الكتاب المنزل وتأويل الظاهر اللامعقول منه وفي فهمهم للوجود.
ثمَّ أشار ابن رشد (1991) إلى أنَّ تناقض ظاهر الآيات مع أحكام العقل هو دليل لأصحاب طريقة البرهان على وجوب تأويل تلك الآيات للوصول إلى المعنى الموافق للعقل (ص36). من هنا، يظهر لنا أمران: الأول، أنَّ العقل وأحكامه يشكلان مرجع الحقيقة الأوّل لأصحاب طريقة البرهان، أي أنّ حُكم العقل عندهم يعلو حكم الشَّرع لأنَّ الدليل على وجوب استعمال منهج التَّأويل لفهم معاني الآيات هو تعارض ظاهرها مع أحكام العقل. فعند وقوفهم في الكتاب المنزل على معنى ظاهر يتعارض مع أحكام العقل يجب على أصحاب طريقة البرهان تأويل الآية بحثًا عن معنى خفيّ معقول يكون سبيلًا لهم إلى إصابة المعرفة والتصديق بحقائق الوحي. أمَّا الأمر الثاني فهو أن بقيّة الناس، وهم الأكثرية، يجب عليهم الأخذ بالظاهر اللامعقول كما هو، بالرغم من تناقضه مع أحكام العقل.
إذًا، حصر ابن رشد مقاربته للموضوع بتبيان إجازة الشرع لاستخدام النظر العقلي والمناهج العقلية في دراسة العلوم الشرعيّة وفهم حقائق الوجود، وإظهار وجوبه لقلّة من الناس؛ ولكنّه لم ينفِ وجود سبل أخرى لا تشترط إعمال العقل وتطبيق أحكامه لتحقيق هذا الغَرَض. فابن رشد لم ينف قدرة الناس الذين ينتمون إلى النوعَيْن الآخرين - أي الجدليين والخطابيين - على الوصول إلى معرفة الله والإيمان والتصديق به، و تاليًا تحقيق شروط نيل السعادة الأبديّة بالرغم من عَجْزهم عن فهم المعاني المعقولة التي يصل إليها أهل البرهان من خلال تأويل الظاهر اللامعقول. وقد جزم ابن رشد (1991) بأنَّه يُمكن للجدليين والخطابيين الوصول إلى الإيمان من خلال التصديق بالظاهر ولو كان لاعقلانيًّا عندما أوجب منعهم من قراءة التأويلات البرهانية للظاهر اللامعقول وإلزامهم الوقوف عليهما والتصديق به، لأنّ هدمه لهم عبر التأويل يؤدّي بهم إلى الكفر:
وهذا التأويل ليس ينبغي أن يُصرَّح به لأهل الجدل فضلًا عن الجمهور (أي الخطابيين). ومتى صرّح بشيء من هذه التأويلات لمن هو من غير أهلها، وبخاصّة التأويلات البرهانية لبُعدها عن المعارف المشتركة، أفضى ذلك بالمصرَّح له والمصرِّح إلى الكفر. والسبب في ذلك أنَّ مقصوده إبطال الظاهر وإثبات المؤول، فإذا بَطَلَ الظاهر عند من هو من أهل الظاهر، ولم يثبت المؤوَّل عنده، أدَّاه ذلك إلى الكفر، إن كان في أصول الشريعة. (ص52)
كلام ابن رشد هذا في غاية الوضوح، فهو يقول إنَّ المعنى العقليّ الناتج من التأويل يُبطل المعنى الظاهر المنافي لأحكام العقل، وإنَّ الجدليين والخطابيين يعجزون عن إدراكه لعجزهم عن إدراك المعاني المعقولة. وإنَّ حفظ إيمانهم وحقّهم بالسعادة الأبدية يشترط منعهم من التعرُّض للمعنى المؤوَّل لأنَّه معنى عقليّ يبطل المعنى الظاهر. فإذا هُدِم لهم الظاهر بتأويله أنكروه، وبعجزهم عن المعنى العقليّ لا يصلون إلى الحقيقة فيخرجون إلى الكفر. وهذه نقطة إشكاليّة في مقاربة ابن رشد. فكيف يمكن أصحاب طريقة البرهان أنفسهم القبول بهذه المقولة، وفي رأيهم ما ينافي أحكام العقل هو باطل؛ فكيف يجوز أن يكون التصديق بالباطل سبيلًا إلى معرفة الله ونيل السعادة الأبديّة؟ للأسف، لا يجد الباحث في كتاب فصل المقال جوابًا عن هذا السؤال المشروع. وسيظهر لاحقًا في سياق هذا البحث أنَّ الخطاب القرآنيّ لم يُشر إلى سبيل آخر غير العقل طريقًا لفهم حقائق الوحي وتحقيق الإيمان والوصول إلى النجاة والفوز بالسعادة الأبديّة.
بالرغم من التباين الموجود بين موقف ابن رشد تجاه علاقة العقل بالشرع وموقف الغزالي، فإنَّ الأخير قارب هذه المسألة أيضًا من باب الحُكْم ما إذا كان العقل هو الأداة المعرفيّة أو القوّة الإدراكيّة التي تُدرَك بها حقائق الشَّرع والوجود، أم تلك الحقائق تُدرك بأداة أخرى غير العقل وأعلى منه. وقد قسَّم الغزالي (2006/7) في كتابه المنقذ من الضلال أطوار الإدراك التي يدرك الإنسان فيها أنواع الموجودات إلى أربعة: الحسّ والتمييز والعقل وعين النبوّة (ص 66). وفيما يكتسب عموم الناس الحواسّ في سنّ مبكّرة، ثمّ يكتسبون بعدها التمييز في سنّ السابعة ومن ثمَّ العقل عند البلوغ، لا يقدر على أن يكتسب عين النبوّة إلَّا القليل منهم، وهم الذين يسلكون مسالك الزهد وتنقيَة القلب من كلّ ما هو سوى الله. ويشرح الغزالي عن طور العقل وعين النبوّة، فيقول:
ثمّ يرتقي إلى طور آخر، فيخلق له العقل، فيدرك الواجبات والجائزات والمستحيلات وأمورًا لا توجد في الأطوار التي قبله. ووراء العقل طور آخر تنفتح فيه عين أخرى يبصر فيها الغيب وما سيكون في المستقبل، وأمورًا أخرى العقل معزول عنها كعزل قوّة التمييز عن إدراك المعقولات (ص 66).
إذًا، عين النبوّة هذه هي بحسب الغزالي أداة المعرفة التي تُدرك الحقائق المخفيّة عن الوجود، والتي يسمّيها خواصّ الأشياء. ويضيف الغزالي العبادات الدينيّة بفروعها الإيمانيّة والمعرفيّة والمسلكيّة - وبالتالي حقائق الوحي - إلى نوع الموجودات الغيبيّة التي لا تُدرك إلَّا بعين النبوة ويعجز العقل تاليًا عن إدراكها. ثمَّ إنَّه جعل هذه العبادات أدوية للأرواح اللطيفة وحياة لها. غير أنَّه لم يربط بين صحّة هذه الأرواح وسلامتها وبين الطبيعة العاقلة، بل ربطها بمعرفة الله والطاعة له والرغبة في طلبه. وبما أنَّ الله من الغيب، فإنَّ معرفته هي فعل عين النبوة بالأصالة، وفعل العقل بالمداورة وذلك بتعلّمها عن الأنبياء والأولياء والتصديق بها. لذا، فإنَّ العقل لا يقدر على الوصول إلى معرفة الله بقدرته الذاتيّة، بل يصل إلى هذه المعرفة باقتباس المعارف الدينية التي يصل إليها الأنبياء والأولياء بقدرة عين النبوة التي تنفتح لهم كما ذكر أعلاه نتيجة الزهد والإخلاص بمحبة الله ومخالفة الأهواء وتصفية القلوب، وبقبول هذه المعارف كما هي. ويقول الغزالي (2006/7) في هذا معنى:
وكما أنَّ أدوية البدن تؤثّر في كسب الصحّة بخاصيّة فيها لا يدركها العقلاء ببضاعة العقل، بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين أخذوها من الأنبياء الذين اطّلعوا بخاصيّة النبوة على خواصّ الأشياء، فكذلك بان لي، على الضرورة، أنَّ أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدّرة من جهة الأنبياء، لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء، بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواصّ بنور النبوة لا ببضاعة العقل. (ص 71).
ويعتبر الغزالي أنَّ أيّ محاولة لفهم خواصّ العبادات ومقاديرها وحدودها بعين العقل هي ضرب من ضروب الحمق والجهل لأنَّ العقل أعمى عن تلك الخواصّ ويعجز عن فهمها لأنّها من اختصاص عين النبوة:
فكذلك العبادات التي هي أدوية داء القلوب، مركّبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار، حتى إنَّ السجود ضعف الركوع، وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدار ، ولا يخلو عن سرّ من الأسرار، هو من قبيل الخواصّ التي لا يطّلع عليها إلّا بنور النبوّة. ولقد تحامق وتجاهل جدًّا من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة، أو ظنَّ أنّها ذكرت على سبيل الاتّفاق لا عن سرّ إلهيّ فيها يقتضيها بطريق الخاصيّة. (ص72)
إذًا، من يحاول إدراك خواصّ العبادات بالعقل عن جهل منه بعجز العقل عن إدراكها، سيقوده ذلك الجهل إلى استهجان تلك العبادات وإنكار وجود خواصّ فيها تشفي القلوب من الأمراض الدينيّة. فلجهله السبب الحقيقيّ لعجز عقله عن إدراك خواصّ العبادات، يظنّ أنَّ ذلك دليل على عدم وجود تلك الخواصّ (ص66-67). ولكن، وبما إنَّ خواصّ العبادات وحدودها ومقاديرها تُدرك فقط بعين النبوة لا بنور العقل، لا يبقى للعقل بنظر الغزالي خاصيّة ولا فائدة إلَّا تمكين المؤمنين من فهم صورة العبادات - أي التعاليم والأعمال والشعائر إلخ - وشروطها، وإدراك عجزه عن معرفة خواصّها، ومن ثمَّ تفسير سبب عجزه عن إدراكها للمؤمنين؛ وهو أنَّها تقع خارج دائرة نظره. ويوضّح الغزالي خاصيّة أخرى للعقل وهي إقناع المؤمنين بضرورة التسليم للأنبياء والأولياء فيما يعلّمونه للناس عن تلك العبادات لكون هؤلاء قادرين على إدراك خواصّها بعين النبوّة. ويصل الغزالي إلى غاية احتجاجه هذا ليقول إنَّ وظيفة العقل هي أن يهدي المؤمنين إلى ضرورة الاتّباع والتقليد الأعمى للأنبياء والأولياء في أمور الدين والعبادات:
وعلى الجملة فالأنبياء أطبّاء أمراض القلوب، وإنّما فائدة العقل وتصرّفه إن عرّفنا ذلك، ويشهد للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعجز عن درك ما يدرك بعين النبوة، وأخَذَ بأيدينا وسلّمنا إليها تسليم العميان إلى القائدين، وتسليم المرضى المتحيّرين إلى الأطبّاء المشفقين، وإلى ههنا مجرى العقل ومخطاه وهو معزول عمَّا بعد ذلك، إلّا عن تفهّم ما يلقيه الطبيب إليه. (ص 72)
ويبدو أنَّ الغزالي حرص على الانسجام بتفكيره مع مقولته هذه، فذكر مباشرة بعدها أنَّه وصل إلى هذه النتائج عن خواصّ العقل بواسطة عين النبوة وليس بالنظر العقليّ، حيث قال: "فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية مجرى المشاهدة، في مدّة الخلوة والعزلة (ص 72)"؛ والمشاهدة المذكورة هي فعل عين النبوّة.
إذًا، وكما سبق أن ذُكر، يتبيّن من التحليل المدرج أعلاه أنَّ الغزالي قد حصر علاقة العقل بالدين والشرع في المجال المعرفيّ والإدراكي، وجعله خادمًا للتقليد والاتّباع الأعمى للأنبياء والأولياء، يعجز عن إدراك خواصّ الموجودات جميعًا، أكانت روحيّة، مثل النفس وأمراضها وأدويتها من العبادات، أو طبيعيّة، مثل أحوال البدن وأمراضه وأدويته ومثل الأفلاك. وبالتالي، عزل الغزالي الدين والشرع عن أحكام العقل وجرّده من أهليّته للحكم على مسائل الشرع، وأعطاه دور التابع الأعمى لعين النبوّة.
وإذا ما قارنَّا بين غاية ابن رشد من كتابه فصل المقال وغاية الغزالي من المنقذ من الضّلال نرى فارقًا مهمًّا يمكن تفسيره على النحو التالي: حاول ابن رشد أن يجد للعقل من حيث هو قوة إدراك الحقّ مكانًا أصيلًا وشرعيًّا في الدِّين، وجعل تعارض ظاهر الشرع مع العقل إرادة إلهية مقصودة تهدف إلى تنبيه أصحاب الطباع العقليّة التي تبني التصديق على البرهان إلى ضرورة تأويل هذا الظاهر اللاعقلاني سبيلًا للوصول إلى الحقائق العقلية الخفيّة. أمَّا الغزالي فلم يكن يرى من ضرورة للتوفيق بين العقل والشرع، كما لم يرَ إشكالية في تعارض ظاهر الشرع مع العقل، ولم يعتبر أنّ ذلك يضرب مصداقية الشرع؛ بل على العكس، رأى فيه تفوُّق الشرع وعجز العقل عن معرفة الحقائق. ويشرح الغزالي فهمه لموقف بعض العقلاء من الآيات ذات الظاهر اللاعقلاني في الشرع على النحو التالي: "وكما أنَّ المميّز لو عرضت عليه مدركات العقل لأباها واستبعدها، فكذلك بعض العقلاء أبى مدركات النبوة واستبعدها؛ وذلك عين الجهل، إذ لا مستند له إلَّا أنَّه طور لم يبلغه ولم يوجد في حقه فظنَّ أنَّه غير موجود في نفسه" (ص 67). قَبِلَ الغزالي إذًا احتمال أن يكون بعض الشرع مناقضًا لأحكام العقل من دون أن يجعل لذلك التناقض فائدة عقليّة كما ذكر ابن رشد، وتفهّم استهجان العقلاء منه وإنكارهم إياه؛ غير أنَّه رأى في ذلك كلّه إثباتًا لعجز العقل ومحدوديّة قدرته! وسيتبيّن لاحقًا عدم انسجام مقولات الغزالي هذه مع الخطاب القرآني عن العقل ودوره في الدين والعبادة الروحيّة.
أشار الخطاب القرآني إلى أهميّة الاستفادة من خصائص اللغة العربيّة واصطلاحاتها في فهم معاني آيات الكتاب المنزل حيث قال: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (يوسف/2). لذا، أجد من المفيد، قبل الخوض في تحليل الآيات القرآنية، تقديم بعض المعاني اللغوية للفظة "عقل" كما وردت في أمّهات المعاجم التراثية، لما يساعد ذلك في توضيح كثير من التفسيرات التي سَتَرِدُ لاحقًا في هذا البحث عن علاقة العقل بالدين والإيمان. عَرَّف الجوهري (1990/5) "العقل" في صِحَاحِه بأنَّه: "الحِجر والنُهى. ورجل عاقل وعقول. وقد عقل يعقل عقلًا ومعقولًا أيضًا، وهو مصدر، وقال سيبويه: هو صفة" (ص 1769). وفي تعريف الجوهري كما سيتبيّن لاحقًا دلالة على وظيفة العقل الخُلقيّة، بحيث هو القوة الداخلية الوازعة التي تَنْهَى النفس وتحبسها عن متابعة الشهوات الجسمانيّة والاندفاع وراء الغضب بغير رويّة ولا بصيرة.
أمّا الفيروزآبادي (1998) فقد عرَّف "العقل" في قاموسه المحيط بأنّه:
العِلم بصفات الأشياء، من حسنها وقبحها، وكمالها ونُقصانها، أو العلم بخير الخيرين وشر الشرّين، أو مطلق لأمور أو لقوة بها يكون التمييز بين القبح والحسن ولمعانٍ مجتمعة في الذهن يكون بمقدِّمات يستتبّ بها الأغراض والمصالح، ولهيئة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه، والحقّ أنّه نور روحانيّ به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظريّة ... يكْمُل عند البلوغ، ج: عُقُول، عَقَلَ يعقل عقلًا ومعقولًا وعقَّل، فهو عاقِل من عُقلاء وعُقَّال... والشيء فَهِمَه، فهو عَقُول... (ص1033-1034).
ويشير تعريف الفيروزآبادي إلى وقوع العقل على فعل الإدراك للعلوم الضروريّة والنظريّة من جهة، وعلى القوّة الإدراكيّة التي تُمكِّن النَّفس من نَظَرِ هذه الأمور اللَّطيفة؛ ويقع أيضًا على قوة التمييز. غير أنَّه أشار أيضًا إلى وقوع العقل على "هيئة محمودة للإنسان في كلامه وحركاته"، أي مسلكه في الحياة، ما يجعل العقل صفة لطريقة محمودة في العيش.
وأمَّا ابن منظور (1994/11) فقد أورد في لسان العرب عن معاني العقل:
[عن] ابن الأَنباري: رَجُل عاقِلٌ وهو الـجامع لأَمره ورَأْيه، مأْخوذ من عَقَلْتُ البَعِيرَ إِذا جَمَعْتَ قوائمه، وقـيل: العاقِلُ الذي يَحْبِس نفسه ويَرُدُّها عن هواها، أُخِذَ من قولهم قد اعْتُقِل لِسانُه إِذا حُبِسَ ومُنِعَ الكلامَ، والـمَعْقُول: ما تَعْقِله بقلبك... والعقل: التثبُّت في الأمور. والعقل: القلب... وسُمّي العقل عقلًا لأنّه يَعْقِل صاحبه عن التورُّط في المهالك أي يحبسه. (ص 458-459)
تتَّفق هذه المعاني مع ما ورد في الصحاح عن الوظيفة الخلقيّة للعقل، ولكن يضيف ابن منظور بُعدًا آخر مهمًّا، وهو أنَّ العقل هو صفة تطلق لا على قدرة المرء على ضبط مشاعره وأعماله على نظام الحقيقة وحسب بل وضبط فكره ، لأنَّ العاقل "هو الجامع لأمره ورأيه". إذًا، وبحسب هذا المعنى، باكتساب العقل يتمكَّن الإنسان من جمع نفسه بكلّيتها على نظام الحقّ ومن منعها عن الباطل. وسيظهر لاحقًا أنَّ جميع هذه المعاني مفيدة في فهم الأبعاد المتعدّدة لمعنى العقل في الخطاب القرآني وعلاقته بالدين والإيمان.
العقلُ والهُويَّةُ الإنسانـيّةُ
يُخاطب القرآنُ الإنسانَ في مواضِعَ عدَّة بما هو نفسٌ عاقلةٌ، كما في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (الأنفال/24). بالطبع، تلك الدعوة مُوجَّهة إلى بشرٍ أحياءٍ في أجسامهم؛ وهي بالتالي تشير إلى حياة غير الحياة الجسمانيَّة. كما أنَّ التعاليم الدينية هي معانٍ روحيةٌ لا تُـحيي أجسامًا طبيعية، بل تُؤثِّر في الإنسان من خلال طبيعته الـمُدركة للأشياء غير الحسيَّة، والتي هي النفس العاقلة. فوَحْدَهَا العُقُولُ تحيا بالعلم والحكمة، كما في قوله: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام/122). مِنَ الواضح أنَّ الخطاب القرآني يربط بين الحياة والنور الذي هو العلم الحقُّ، ويجعلهما نقيضَي الموت والظلمة اللَّذَيْن هما على التوالي الكفر والجهل. وفي ذلك دلالةٌ واضحة على أنَّهُ قصد بالحياة حياة النفس العاقلة لا حياة الجسم.
وممَّا يُثبت أيضًا أنَّ الخطاب القرآني قَصَدَ عند استخدامه عبارتي الحياة والموت حياةَ النفس العاقلة وموتَها إطلاقُه صفة الموت على الكُفّار في أكثر من موضع، مثل قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ ... *أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء﴾ (النحل/20-21). وهؤلاء أيضًا أحياءٌ في أجسامهم ولكنَّهم موتى في نفوسهم العاقلة، لأنَّ الإيمان والكفر كليهما من أعمال القلب، أي النفس العاقلة، كما في قوله عن الإيمان: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (الحجرات/14)، ومثل قوله: ﴿مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ (النحل/106)، وقوله عن الكفر: ﴿وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ﴾ (النحل/106)؛ وقال أيضًا: ﴿فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ﴾ (النحل/22). ثمَّ إنَّ الخطاب القرآني أوضح أنَّ القلوبَ لها أعمالٌ خاصة بها بمعزل عن الجوارح الجسمانيّة، بدليل قوله: ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (البقرة/225)، أي النفوس العاقلة. وبما أنَّ القلوب تكسب الأعمال يعني أنّها عاملة ومُتحركِّة، أي حيّة.
إذًا هناك نَسَقٌ واضحٌ في الخطاب القرآني يجعل النفس العاقلة هويةَ الإنسان وجوهرَهُ؛ ويجعل حياته حركةَ تلك النَّفسِ في النور والخير والحقّ، والفساد والموت حركتها في الظلمة والشرّ والباطل. ويستتبع من ذلك أنَّ الخطاب القرآني عندما يخاطب الإنسان إنّما يخاطبه بما هو تلك الهوية، وعندما يصف أحواله من حياةٍ وموت وبصر وعمى، وطيب وخبث، وغيرها إنّما يصف أحوال تلك النفس العاقلة بالذات.
العَقْلُ هُوَ قُوَّةُ الإدراكِ المُخْتصّةُ بحَقائِقِ الوحْي
ولـمَّا جعل الخطاب القرآني النفسَ العاقلة للإنسان هويته الحقّة كان من الطبيعي أن يجعل للعقل دورًا رئيسًا في إدراك هذه النفس لحقائق الوحي. وقد أشار الخطاب القرآني إلى محوريَّة العقل من حيث هو قوة الإدراك المختصَّة بحقائق الوجود في غير آية أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قوله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا... فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحج/46)، أي العقل وهو البصيرة القلبية أو بصيرة النفس التي بها تُدْرِكُ حقائق الوجود. وتبيّن الآية أن بالعقل يحصل الاعتبار وإدراك الحقائق وبفساده يتعطَّلان. وكيف لا تكون حقائق الوحي معانيَ معقولة أيضًا وقد قال: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (يوسف/2). فهذه الآية تبيِّن بوضوح أنَّ السبب من وراء نزول الوحي بلغة العرب هو أن يتمكَّنوا من عَقْلِ معانيه، أي فهمها؛ ما يعني أنَّ حقائق الوحي هي معان معقولة. وقال كذلك: ﴿قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ؛ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ﴾ (الملك/9-11). من الواضح أنَّ هذه الآيات تَربِط بين العَقْل بما هو فعل الإدراك للمعاني المعقولة وبين إدراك حقائق الوحي وتعلُّمها وذلك بجعلها علّة التكذيب بتعاليم "النذير"، أو النبي المرسل، عَدْمَ عَقْلِ الكفار لمعاني الوحي لقولهم "لو كنّا نسمع أو نعقل". ودلالات هذا الربط واضحة أيضًا، فهي تشير إلى أنَّه لا يمكن الناسَ أن يَفهموا معاني الآيات وحقائق الوحي إلًّا بواسطة العقل. لذا، وبخلاف ما اعتقده الغزالي بأنَّ العقل عاجز عن إدراك حقائق الوحي، بأنَّه يمكن الناس فهم حَقائقه من دون الاعتماد على العقل، يوضّح الخطاب القرآني أنَّ العقل هو قوة (أو أداة) الإدراك المختصَّة بهذه الحقائق؛ وبالتالي، وحدهم أصحاب العقول السليمة يمكنهم تحقيق مثل هذا الإدراك.
كذلك، لا ينسجم الخطاب القرآني مع مقولة ابن رشد بأنَّه يمكن الناسَ الذين ينتمون إلى صنف الخطابيين والجدليين الوصول إلى معرفة الله والإيمان به من دون الحاجة إلى فهم الحقائق المعقولة للوحي، وبخاصة عندما يكون ظاهره مُنافيًا لأحكام العقل، لقوله: ﴿فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ﴾ (يونس/32). وتشير هذه الآية بوضوح إلى أنَّه عند وجود اختلاف بين ظاهر الوحي وأحكام العقل أو المعاني المستنبطة من الآيات بواسطة العقل، يُضاف هذا الظاهر اللامعقول حكمًا إلى الباطل، ولا يمكن الباطل أن يكون طريقًا إلى معرفة الله وسبيلًا لنيل السعادة الأبدية لقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (العنكبوت/52). فبحسب هذه الآية، إنَّ من يؤمن بالباطل يكفر بالله ويخسر السعادة الأبدية. وكذلك، لا يمكن حقائقَ الوحي أن تختلف وتتناقض بعضها مع بعض كما يحدث عند اختلاف الظاهر اللامعقول مع المعنى المؤوّل المعقول، لأنَّ الخطاب القرآني قد أشار إلى استحالة وجود اختلاف بين معاني آيات الكتاب المنزل، لقوله: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾ (النساء/82). والتدبّر هو عمل عقلي إذ يعرّفه الفيروزآبادي في القاموس المحيط (1998) على أنَّه "النَّظَرُ في عاقِبةِ الأمرِ، ... و[تدبَّر] الأمر رأى في عاقِبتهِ ما لم يرَ في صَدْرِهِ، وتدبَّر القول أي فهم غايته" (ص 390). وبالتالي، تفيد هذه الآية أنَّ من يقارب الوحي بواسطة العقل لا بدَّ من أنْ يجد معانيه مُتّسقة ومتجانسة لا تحمل فيما بينها اختلافًا ولا تناقضًا، لأنَّ الحقّ الذي من عند الله متجانس المعنى لا اختلاف فيه.
العَقْلُ غايةٌ مِنْ غَايات الرِّسالَةِ النَّبَوِيَّةِ
وإذا ما تتبَّعنا في النصّ المنزل الآيات التي تُوضّح أغراض الوحي والرسالة النبويّة، نُلاحظ أنَّها تجعل تَيْقِيْظَ النفس العاقلة في الإنسان وتنميَتها أحد أبرز أغراضها. فقد أوضح الخطاب القرآني أنَّ الغاية من التعاليم التي يحملها الوحي هي تنوير العقل الإنساني بقوله: ﴿قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾ (الأنعام/104)؛ ومقصد الكلام بصيرة النفس، أي العقل. فقد دلَّ الخطاب القرآني على التعاليم الإلهيّة التي يحملها الوحي بالآلة التي تُدْرَكُ بها - أي بصيرة النفس - فأسماها بصائر لكونها تُمكّن هذه البصيرة، أي العقل، من نظر المعاني المعقولة كما يُمكِّن نور الشمس العين من نظر الأشياء المحسوسة، لأنَّ غرض الرسالة هو تعليم الناس الحق كما في قوله: ﴿أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة/151). كذلك، أشار في غير موضع، وبطريقة مباشرة، أنَّ غاية الوحي بآياته وأمثاله وقَصَصِهِ هو إرشاد الإنسان إلى تحقيق فضيلة نفسه العاقلة من خلال تغذيَتِها بالعلم والحكمة، كما في قوله: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة/242)، أي كي تعقلوا. فجعل غاية الآيات وبيان معانيها اكتسابَ المؤمنين القدرةَ على عقل حقائق الوجود.
وأضاف الخطاب القرآني إلى هذه الغاية اكتسابَ المؤمنين القدرة على القيام بأنواعٍ أخرى من أعمال الطبيعة العاقلة وإتقانها من حُسن التفكُّر، كما في قوله: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (البقرة/266)، وقوله: ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الأعراف/176)؛ واليقظة العقليَّة أو الذكر، كما في قوله: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ،﴾ أي ليتذكر الحقائق أولو العقول (ص/29)؛ وحُسن الفهم، كما في قوله: ﴿انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ (الأنعام/65). ثمَّ جعل ذلك كلَّه، أي العقل وحسن التفكُّر والتذكُّر وحسن الفهم، شرطًا للإيمان لقوله: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ... لَعَلَّهُم بِلِقَاء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنعام/154)، أي بعد عَقْلِهِم لمعانيه؛ ليصبح الإيمانُ هو التصديق بمعانٍ عقليَّة غائبة عن الحسّ، أي التصديق بالغيب المعقول وليس بالغيب اللامعقول. فقد ربط الخطاب القرآني بين الإيمان والعَقْل (الفعل) في غير موضع، كما في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ﴾ (يونس/100). وبحسب هذه الآية، فإنَّ من عَجَزَ عن العَقْل عَجَزَ عن الإيمان. فصار العقل شرطًا لتحقيق غاية من غايات الدين وهو الإيمان. لذا، من الواضح أنَّ الخطاب القرآني قصد بالإيمان التصديق بغيب معقول، أي الذي ينسجم مع أحكام العقل ولا يتناقض معه.
والعَقْلُ هُو نَظَرٌ سليمٌ للوجود
ولم يقتصر الخطاب القرآنيّ على جعل التفكُّر في آياتِ الكتابِ وأمثاله وقصصه وعقل حقائقها غذاءً للنفس العاقلة وسببًا لحياتها، بل نبَّه إلى أنّ الوجود الماديّ المحسوس كُلّه آيات حسيَّة ماثلة أمام نظر المؤمن لإيقاظ هذه النفس العاقلة وتنميتها وإحيائها بعد أن يُدرك بعقله دلالتها وممثولاتها من الحقائق. فقد أوضح الخطاب القرآني أنَّ كثيرًا من الظواهر الطبيعية المألوفة تحمل دلالات تساعد الإنسان على إدارك حقائق الوجود متى أعمل عقله في فهم معانيها وممثولاتها، كما في قوله:
﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ * يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ (النحل/10-13).
فبحسب هذه الآيات فإنَّ جميع هذه الظواهر المألوفة في العالم المحسوس لها دلالات ومعانٍ يمكن الناظر نظر الاعتبار أن يعلمها بواسطة العقل. ولنا في قصّة النبي إبراهيم الخليل مثال مفيد على كيفية درك حقائق الوجود من خلال الاعتبار بالظواهر الطبيعيَّة.
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (الأنعام/75-79)
فقد نظر إبراهيم إلى كوكب[1] منير في السماء وبعده إلى القمر والشمس معتقدًا فيها الألوهة واحدًا بعد الآخر، فلمَّا أفلت، أي غابت عن النظر، أدرك بعقله أنَّه لا يمكن الإله أن يكون من جنس الآفلين، فيلحقه عجز أو فناء، فنزّه الإله عنها وعلم أنَّه يجب أن يطلب الألوهة في الذي لا يلحق به عجز وفناء، أي الله. بالطبع، كان ظنُّ النبي إبراهيم أنَّ في الكوكب ألوهة وليد النظر الحسّي الذي رأى في علو مكانه في السماء شرفًا وفي أنواره فضلًا، ثمَّ اعتقد بالقمر لكونه أكبر وأشدّ نورًا منه وانتهى إلى الاعتقاد بالشمس لأنّها أشدُّ من الاثنين نورًا وفضلًا. وأمَّا ما أدركه من معاني غيابها ووقوع التغيير في أحوالها ودلالات ذلك من عجز وضعف، وتنزيهه الخالق عنها فهو وليد النظر العقليّ. وكأنَّما أراد الخطاب القرآني أن يقول إنَّها جميعًا فُطرت على أحوالٍ ظاهرة تساعد الإنسان الناظر إليها بعقله على الاعتبار بها ومعرفة أنّها ليست الخالق.
ثمَّ أشار الخطاب القرآني إلى مثل آخر من الطبيعة له أهميّة كبيرة في الدين لكونه يوضّح للإنسان الناظر بعقله فناء الدنيا كي يعلم فضلَ الآخرة عليها فيطلبها، كما في قوله:
﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (يونس/24).
والعبرة من وراء المثل المذكور أنَّ كلّ شيء ينمو في العالم الماديّ المحسوس، ومن ضمنه جسم الإنسان، وينجذب إليه الإنسان الناظر بعين حسه لحسنه وجماله، هو سائر إلى الفناء، وهو بالتالي أقلُّ فضلًا ممَّا هو باقٍ إذا ما نظر إليه الإنسان بالعقل. إذًا يساعد النظر العقلي إلى الظواهر الطبيعيَّة والاعتبار بها الإنسان على التمييز بين الفناء والبقاء ليعلم بعقله الناظر في العواقب والغايات فضل ما هو باقٍ فيختار طلب الآخرة اختيارًا عقليًّا، أي عن علم ودراية بخيرها وبقائه كما في قوله: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَـهْـوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾ (الأنعام/32).
العُقَّال مقصد الرسالة النبويّة
ويلاحظ أيضًا أنَّ الخطاب القرآني قد جعل في غير آيةٍ أصحابِ العقول الحيّة المقصد الحقيقي للرسالة النبويَّة، فقد أشار إلى أن غرض آيات الكتاب المنزل هو تذكير القلوب الحيّة بالحقائق الإلهية، كما في قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ،﴾ أي في آيات الكتاب، ﴿لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ،﴾ (ق/37) أي لمن كان له قلبٌ حيّ. ثمَّ أوضح معنى ذلك في قوله: ﴿لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا﴾، أي في قلبه أو نفسه العاقلة، ﴿وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (يس/70)، أي لتقوم حجّة البيان على الأموات في نفوسهم العاقلة. وهذان القولان يُفيدان التخصيص لأنّهما يشيران إلى أنَّ القلوب الحيَّة هي وحدها تتذكَّر معاني الآيات المنزلة وتنتذر بوعيدها كما في قوله: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾ (ص/29)، وقوله ﴿هَذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ﴾ (إبراهيم/52)، أي أصحاب القلوب أو النفوس العاقلة الحيّة. وهذه الآية تشير أيضًا إلى أنَّ النفس العاقلة هي التي تحمل التوحيد معتقدًا بعد عقلها لحقائق الرسالة.
ثمَّ أوضح الخطاب القرآني أنَّ هذا التخصيصَ ليس من باب التَّمييز المسبق بين الناس، فيستحيل ضربًا من ضروب الظلم الناتج من عدم المساواة بينهم في التبليغ والبيان؛ بل هو لتبيان أنَّ من أهمل طبيعته العاقلة وأفسدها يحرُم نفسَهُ بنفسِهِ من القدرة على عَقْل الحقائق الإلهية والتصديق أو الإيمان بها، وبالتالي الانتفاع بها دليلًا للنَّجاة، كما في وصفه للكفّار بأنَّهم: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة/171)، أي أنَّ كفرهم حرمهم القدرة على النظر العقلي فيه وفهم معانيه، بدليل قوله: ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾[2] (النساء/155).
إذًا، تَرِدُ الرسالة على جميع الناس من باب إقامة العدل فيهم؛ ولكن لن يقبلها وينتفع بها إلَّا ذوو العقول الحيّة، أو العقّال، فيصبح هؤلاء هم مقصدها الحقيقي لقوله: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ. وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ﴾ (الأنفال/22-23). وليس من الحكمة والعدل إطلاق الذمّ على من لم يتسبَّب لنفسه بما يوجب الذمّ؛ وبالتالي، لا بدَّ من أنَّ الخطاب القرآني قد قصد بـ"شرِّ الدواب" مَنْ أُعْطِيَ القدرة على عقل حقائق الوحي، أي الإنسان العاقل بالفطرة، ثمَّ أفسد هذه القدرة وعَدِمَها بما اكتسب من أعمال سيئة، كما في قوله: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي... نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا... وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ (طه/123-127). تُثبت هذه الآيات أنّه قصد بِـ"شَرِّ الدواب" مَنْ كَفَر بحقائق الآيات المنزلة مع وجود القوة على عَقْلِها والتصديق بها، وأنَّ هؤلاء مسؤولون عمَّا وصلوا إليه من عجزهم عن عَقْلِ المعاني بسبَب إهمالهم لتغذيَة نفوسهم بحقائق الوحي. وإذا كانت الأشياء تُعرف بأضدادها، يُصبح خير الدواب كل من سمع الحقّ ونظر معانيه بعقله فأدرك حقائقه المعقولة.
الطَّبيعَةُ العاقلةُ تنفَعِل بالأعمال
ثمَّ أوضح أيضًا أنَّ هذه البصيرة القلبيَّة التي هي العقل، تَنْفَعِل بأعمال الإنسان سلبًا أو إيجابًا ، فإمَّا أن تصفو وتزكو وتزداد بالأعمال الحسنة أو تتَّسخ وتضعف نتيجة للأعمال السيئة، وقد تبلغ درجة عالية من الفساد فتعمى، أي تعدم القدرة على نظر الحقائق المعقولة بدليل قوله: ﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (الإنفطار/14)، أي يكسبون من أعمال السّوء. والرَّانُ هو "الصدأُ الذي يعلُو الشيءَ الجَلِيّ كالسيف والمرآة ونحوهما، ورَانَ الذَّنْبُ على قلبه... غلب عليه وغطاه، كلّ ما غطى شيئاً فقد رانَ عليه" (إبن منظور، 1994/13، ص192)، فيحجبه؛ وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ؛ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ﴾ (البقرة/7).
وإذا كان للنفس العاقلة حياةٌ كما سبق أن ذُكر، فهي إمَّا تكتسب العافية أو تعرض لها الأمراض، أو يحلّ بها الموت. وقد أشار الخطاب القرآني في مواضع عدّة إلى مرض القلوب كما في قوله: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ (البقرة/10). ثمَّ أوضح أنه يتحدَّث عن أمراض روحيّة وليس جسمانيّة، بوصفه مواعظ الكتاب بأنَّها: ﴿شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُور﴾ (يونس/57)، أي شفاءٌ للقلوب أو للنفوس العاقلة من الأمراض المتَّصلة بطبيعتها الخاصة. وقد ربط الخطاب القرآني المرض بالنفس العاقلة والإيمان كما في قوله: ﴿وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ (المدثر/74). وسؤالُ الكافرين والذين في قلوبهم مرض يُعبِّر عن عَجزهم عن فهم معاني الأمثال لكونها معاني معقولة بدليل قوله: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (العنكبوت/43). وفي هذا دليل آخر على ما سبق أن ذكر بأنَّ النفس العاقلة هي هوية الإنسان الحقيقية، لأنَّ الخطاب القرآني أشار إلى فسادها (أو مرضها) عند حديثه عن فساد الإنسان. وقد ربط الخطاب القرآني بين كثير من مظاهر الفساد التي تحلُّ في الإنسان بفساد العقل وعدمه كما في قوله: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ﴾ (آل عمران/58)، أي أنَّه جعل علّة اتخاذهم الصلاة هزوًا عجزهم عن إدراك المعاني المعقولة؛ وقوله أيضًا: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة/171). ويظهر هذا التحليل بوضوح عدم انسجام الخطاب القرآني مع ما ذهب إليه الغزالي من فَصْل نفس الإنسان وأمراضها عن طبيعتها العاقلة.
أشار الخطاب القرآني أيضًا إلى أنَّ الغرض من إلزام المؤمنين اجتناب النواهي، وهو فعل التقوى، الحفاظ على سلامة القلوب وحفظ حياتها، لأنَّ ما نُهِيَ عنه من أقوالٍ وأعمالٍ ومعتقداتٍ هو ما يُمرض الطبيعة العاقلة ويُفسدها، بدليل قوله: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا... وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (الأنعام/151)، أي كي تعقلوا. وتربط الآية بشكل واضح بين الإرادة الإلهيّة بتحريم المعتقدات الخاطئة والأعمال السيئة، والتي يطلق عليها شرعًا "النواهي"، والقدرة على العقل؛ ويتضح بالتالي أنَّ المقصد من الدعوة إلى اجتناب هذه النواهي هو صيانة العقل من أسباب الفساد. لذلك، كانت التقوى - وهي مُشتقَّة من وقاية - من أكثر الفرائض الدينية ذكرًا في النصّ المنزل، لأنّها تحفظ قلب الإنسان - وهو مركز الإيمان والعبادة - سليمًا ومعافًى بتجنيبه كلّ ما يضرّ بطبيعته العاقلة.
وممّا يثبت ارتباط التقوى بالآية المذكورة من سورة الأنعام بالحفاظ على حياة النفس العاقلة وسلامتها، أوْرِدُ أبرز ما أشار إليه الخطاب القرآني من أسباب فساد النفس العاقلة وهلاكها. فقد أوضح أنّ الظَنَّ السوء بالإله - أي المعتقد الخاطئ ومن ضمنه ما ذكر من الشرك - يُميت هذه النفس لقوله: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ﴾ (المؤمنون/41). والرَّدى هو الهلاك والموت، والإنسان كما سبق أن ذكر هو نفسه العاقلة، فيصبح غاية هذه الدلالة على سبب من أسباب موت النفس العاقلة. وقد فسّر الخطاب القرآني ماهيّة هذا الظن المردي بقوله: ﴿يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ (آل عمران/154)؛ هو الظنُّ المبني على الجهل بخلاف ما هو المبني على العلم، أو الحقّ المعقول. ويوضّح هذا التحليل ما أشرتُ إليه في بداية البحث عن اعتباري أنَّ الفَصْل بين الدين والحقيقة والإيمان والعقل يشكّل أخطرَ التحدّيات أمام الدين في العصر الحديث، لأنَّه بفَصْلِ الإيمان عن العقل وبنائه على الجهل بدل العلم هلاكٌ للنفس العاقلة التي هي هوية الإنسان.
ثمَّ ذكر أنَّ عدم التصديق واتباع الأهواء، أي النَّزْعات اللاعقلانيّة، هو أيضًا من أسباب هلاكها، كما في قوله: ﴿فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى﴾ (طه/16). وقد سبق أن ذكر من أنّ للعقل وظيفة أخرى خلقيّة تتمثَّل بكونه الوازع الداخلي الذي ينهى النفس عن متابعة الأهواء، ولأجل ذلك سُمي النُّهى كما في قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُوْلِي النُّهَى﴾ (طه/54)، أي أولي العقول الحيّة. فهذا الوازع الداخلي يمنع مشاعر الإنسان اللاعقلانية من شهوات وغضب من السيطرة عليه وعلى أفعاله كيلا يعمل عمل الجاهلين، بدليل قوله: ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ (الفتح/26)، والحميّة الأنفة. وقد رَبَطَ الخطاب القرآني بين عجز بعض الذين يستمعون إلى الآيات المنزلة عن عَقْلِ معانيها وبين تعطّل العقل وغيابه واتّباع الأهواء في قوله: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا [؟] أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ﴾ (محمد/16). فبحسب الآية فإنَّ السبب وراء عجز هؤلاء عن حمل حقائق الوحي المعقولة هو مرض نفوسهم العاقلة نتيجة اتباع الأهواء. وكذلك، ذَكَر سببًا آخر وهو الظُّلم. فقد أشار إلى حال الظالمين في دار الآخرة بقوله: ﴿أَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ (إبراهيم/42-43)، أي قلوبهم أو نفوسهم العاقلة مَيْتَة بسبب خلوّها من العقل. ثمَّ إنَّ خلاف الظلم هو العدل، والعدل وليد الحق لقوله: ﴿أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ (آل عمران/159)، والحقّ معقول. هذا يعني أنَّ العقل وفق الخطاب القرآني هو أيضًا شرط للحياة المنسجمة مع حقائق الوحي، فلا تحفظ حياة للنفس العاقلة وتصحُّ ديانة ويُنال فَلَاح مع سيرة منفصلة عن العقل وقائمة على الجهل والظلم ومتابعة الأهواء. من هنا أيضًا يمكن فهم ما أورده الفيرزآبادي في قاموسه عن استخدام مصطلح العقل في التعبير عن طريقة محمودة في العيش بقوله إنَّه يستعمل "لهيئة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه".
ويُظهر الخطاب القرآنيُّ أيضًا أهميّة إعمال العقل في فهم الدين والوجود فهمًا صحيحًا وفي حفظ النفوس العاقلة سليمة من أسباب الفساد عند وصفه المؤمنين الأحياء بالعُقَّال الذين يتثبَّتون من أمورهم - وما يختص منها بالرسالة تحديدًا - ويَنْقَدُوْنَها قبل القبول بها أو اختيارها لإلَّا يتبعون ما هو باطل ويجلبون الشرّ والضّرر بدل الخير والنفع، فهم: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾ (الزمر/18)، أي العقول الحيّة. ثمَّ نهى عن السلوك الجاهل والاتباع الأعمى، أي التقليد، بقوله: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء/36)، أي لا تتَّبع أمرًا أو أثرًا إلَّا بعد عَقْلِه ومعرفة حقيقته والتأكُّد من خيره. لذلك، قال عن أصحاب العقول الحيّة: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ (الأنعام/122)، أي هم يعقلون حقائق الوحي فيسلكون في الحياة عن علم ودراية.
وأمَر الخطاب القرآني باتباع مسلك العقل لا مسلك التقليد في الإيمان، وذمَّ مسلك التقليد واتباع ما هو مألوف بين الناس ورَبَطَهُ بالجهل الناتج من عدم العقل بقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ﴾ (البقرة/170). وربما تُوفّر هذه الآية أحد أقوى الإثباتات على محوريّة العقل في فهم الوحي وبناء الإيمان والسلوك الديني؛ فتساؤل الخطاب القرآني عمَّا إذا كان هؤلاء قد تثبَّتوا أولًا من أنَّ آباءهم الذين يتبعونهم في دينهم أو معتقداتهم قد بنوا ما يعتقدونه عن عَقْلٍ، يعني ضمنًا أنَّه لا يجب على الإنسان أنْ يتَّبع إلَّا ما بُني على العقل السليم وتوافق مع أحكامه، أي الحق المعقول. ويتضمَّن هذا السؤال أيضًا استهجانًا من الجهالة التي يعبّر عنها سلوك هؤلاء. كما ويستتبع من هذا أنَّ الخطاب القرآني يدعو جميع الناس، بمعزل عن المكان والزمان، أن لا يكتفوا باتباع ما وجدوا آباءهم عليه من معتقدات وطرق عيش قبل التثبّت من صحتها أولًا كي لا ينتهي بهم الأمر باتباع ما هو مخالف للعقل، أي باطل، فيضلّون عن سبيل الحقّ والخير. وهو بالتالي يدعو الناس، وحتى من كان آباؤهم يتبعون معتقدات صحيحة أو ﴿مَا أَنزَلَ اللّهُ﴾، إلى أنّْ تكون مقاربتهم للوحي وقبولهم لتعاليمه من خلال العقل فعلًا مُتجدِّدًا جيلًا بعد جيل كي يصيبوا الهدى والرشاد ويجتنبوا الوقوع بالجهل والضلال.
ثمَّ أنَّه أوضح لنا السبب وراء تركيزه على تزكية القلب وصيانته من الأمراض بالربط بين سلامته والفوز بالسعادة الأبدية في دار الآخرة بقوله: ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (الشعراء/88-89)، أي إلَّا من أتى للقاء الله بنفسٍ عاقلةٍ حيَّةٍ سليمةٍ من الأمراض. فَمَنْ أفسد بصيرته القلبية بارتكاب السيئات في الحياة الدنيا حَضَر الآخرة وهو أعمى البصيرة فلا يقدر على أن ينظر وجه الله ويحقّق السعادة الأبدية كما في قوله: ﴿وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الإسراء/72)، والعمى هنا في بصيرة القلب أي العقل. والمقصود بالسعادة هنا هي تلك التي عبّر عنها في قوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (القيامة/22-23)، أي إلى وجه ربها ناظرة؛ والشرط في تحقيق هذا النظر هو سلامة القلب، أي العقل. ومما يثبت أنَّ نظر وجه الله هو عنوان السعادة الأبديّة قوله عن عذاب المكذّبين بحقائق الوحي واليوم الآخر:
﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ * الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ * وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ * كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ (المطففين/10-15).
وتفيد هذه الآيات الخمس بأنَّ عاقبة من أفسد نفسه العاقلة وأهلكها باتباع سيرة ظالمة وعَجَزَ نتيجة لارتكابه الأعمال السيئة عن عَقْلِ حقائق الوحي والتصديق بها، فأنكر القيامة وظنّ الوحي وهمًا مضافًا إلى أساطير الأولين، هي الحجبة عن نظر وجه الله في الدار الآخرة. وبما أنَّ الدار الآخرة هي دار خلود، فالحُجبة فيها أبديّة أيضًا. ولا يمكن تعليل مثل هذا الحجبة إلّا بفساد القوة المختصَّة بهذا النظر فسادًا كليًّا وهو ما تعبّر عنه بموت الطبيعة العاقلة للإنسان. وإذا كان العذاب الأليم الذي ينذر منه الخطاب القرآني هو الحجبة عن نظر وجه الله، فلا بدَّ من أن يكون النعيم هو نظر وجهه، وهو يشترط كما ذكر حياة النفس العاقلة وسلامتها من الأمراض. ومن المنطقي أن يكون هذا هو النعيم كونه عنوان البقاء الوحيد لقوله: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن/26-27). غير أنَّ الخطاب القرآني لم يبق الأمر مشكلًا بل أوضح بشكل صريح وفي غير آية أنَّ الغاية من سعي الإنسان في فعل الخيرات والإحسان في دار الدنيَا هو تحقيق هذا النظر في الدار الآخرة، كما في قوله: ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ﴾ (البقرة/272)؛ أي طلبًا للفوز بالنظر إلى وجهه في الدار الآخرة نظر المبصّر المغتبط.
يُظهر هذا البحث الموجز وجود ترابط وثيق بين الطبيعة العاقلة للإنسان بأبعادها كافّة وبين حقائق الوحي والإيمان والسيرة الإنسانيّة ومصير البشر الروحي. فقد تبيّن من خلال دراسة الروابط التي أقامها الخطاب القرآني بين المصطلحات والمفاهيم المتعلّقة بالعقل وبين تلك المتعلّقة بالذات الإنسانيّة وأحوالها أنَّ النفس العاقلة هي جوهر الإنسان وهويته الحقيقية، فحياته حياة هذه النفس وحركته حركتها وموته وموتها. وتبيّن أنَّ العقل هو قوة الإدراك التي تبصر فيها هذه النفس حقائق الوحي ومعاني الوجود لأنَّ هذه المعاني والحقائق هي صورٌ معقولة لا صورٌ محسوسة. ثمَّ بيَّن ارتباط قدرة البصيرة القلبية، التي هي العقل، على درك المعاني المعقولة بالسيرة الإنسانيّة لأنَّها تنفعل بأعمال الإنسان فتحيا بطلب العلم والحكمة والأعمال الحسنة وتنمو، وتحفظ سلامتها وتزكو باجتناب الكفر والشرك والأعمال السيئة واتباع الأهواء، فتقوى على العقل، أو تمرض وتموت بالاسترسال بالجهل والسيرة القائمة على الإسراف والظلم، فتضعف عن العقل أو تعدمه. وأظهر أيضًا أنَّ إحياء هذه النفس العاقلة وتزكيتها وتنميتها وحفظها من الأمراض والهلاك هو غرض الرسالة النبوية والغاية من الأوامر والنواهي التي اشتملت عليها، وهو ما يجعل الكتاب المنزل دليلًا علميًّا وخلقيًّا ومسلكيًّا للعيش العقلي الموصل للسعادة الأبديّة التي هي فعل تلك الطبيعة العاقلة - أي نظر وجه الله. وعلى هذه الخلفيّة، يمكن القول إنَّ الدينَ عقلٌ، فالنفس العاقلة هي حاملة التوحيد والإيمان بعد إدراكها لمعاني الوحي وفهمها لحقائق الوجود بالنظر العقليّ. والعقل أيضًا هو الوازع الداخلي الذي يحبس النفس عن متابعة الأهواء التي تمنعها عن إدراك هذه الحقائق. وبالعقل أيضًا يحقِّق الإنسان غاية الإيمان وهي السعادة الناتجة من النظر إلى وجه الله.
ومن شأن نتائج هذا البحث أن تُعيد الاعتبار إلى المنهج العقلي في تفسير النَّصّ المنزل وتأويله لما يُظهر الخطاب القرآني من شرعيّة هكذا منهج وأصالته، الأمر الذي يفتح الباب أمام مقاربة جديدة للنصّ محرّرة من قيود التراث ومألوفاته. ومن شأن نتائجه أيضًا أن تساعد الباحثين على دراسة النصّ المنزل مجالاً معرفيًّا لاستكشاف الذات الإنسانيّة وعلاقتها بالله وفهم طبيعتها العاقلة وقواها الإدراكيّة والعمليّة والأحوال المختلفة التي تعرض لها واختباراتها وانفعالاتها والمؤثّرات التي تفعل فيها والمصير الذي ينتظرها، الأمر الذي يجعل المعرفة الدينيّة ودراسة النصّ الـمُنزل مطلبًا أشدّ التصاقًا بحياة الإنسان العمليّة واهتماماته العلميّة وهواجسه الوجوديّة. ومن شأنه أيضًا أن يوفّر الأدوات المعرفيّة التي يحتاج إليها الباحثون للقيام بقراءات فلسفية للنصّ المنزل لما يتضمّنه من خلاصات تتَّصل بالطبيعة الإنسانيّة ونظرية المعرفة ونظرية الأخلاق ومفهوم السعادة الإنسانية وغيرها من أغراض المباحث الفلسفيَّة. ولا شكَّ في أنَّ مثل هذه البحوث والقراءات تغني الدّراسات الإسلاميّة خاصّةُ والدينيّة عامةً وتوسع أفق البحث فيها ومجالاته.
- القرآن الكريم.
- إبن رشد، أبي الوليد محمد بن أحمد (595هـ). (1991). كتاب فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال (ط 6، ألبير نصري نادر، موثّق). بيروت: دار المشرق.
- إبن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (711هـ). (1994). لسان العرب (ج 8، 9، 11 و13، ط 3). بيروت: دار صادر.
- الجوهري، إسماعيل بن حمّاد (393هـ). (1990). الصحاح: تاج اللّغة وصحاح العربيّة. (ج 5، ط 4، أحمد عبد الغفور عطار، محقّق). بيروت: دار العلم للملايين.
- عبد الباقي، محمد فؤاد. (1990). المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
- الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد (505هـ). (2006). مجموعة رسائل الإمام الغزالي (ج 7، ط 4، أحمد شمس الدين، موثّق). بيروت: دار الكتب العلمية.
- الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب (817 هـ). (1998). القاموس المحيط. (ط 6، محمد نعيم العرقسوسي، محقق). بيروت: مؤسسة الرسالة.
سعيد أبو زكي، أستاذ جامعي متخصّص في التاريخ والدراسات الإسلاميّة.
[1] غالب الظَّن أنَّه كوكب الزهرة كونه أوَّل ما يظهر في الليل وهو أكثر إشراقًا من بقية الكواكب. وقد يكون المشتري لأنَّه أكبر الكواكب. ومن المعروف أنَّ كثيرًا من شعوب العالم القديم اعتقدوا أنّ في هذين الكوكبين ألوهة.
[2] "وقلب أغلفُ بيِّن الغُلفة: كأنّه غُشِّي بغلاف فهو لا يعي شيئًا" (إبن منظور، 1994/9، ص271). "وطَبَعَ الله على قلبه: خَتَمَ... ويقال طبع الله على قلوب الكافرين... أي خَتَمَ فلا يعي وغطّى ولا يوفّق لخير. وقال إبن إسحق النحوي: معنى طبع في اللغة وختم واحد، وهو التغطية على الشيء والاستيثاق من أن يدخله شيء، كما قال الله تعالى: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد/24)..." (إبن منظور، 1994/8، ص232)
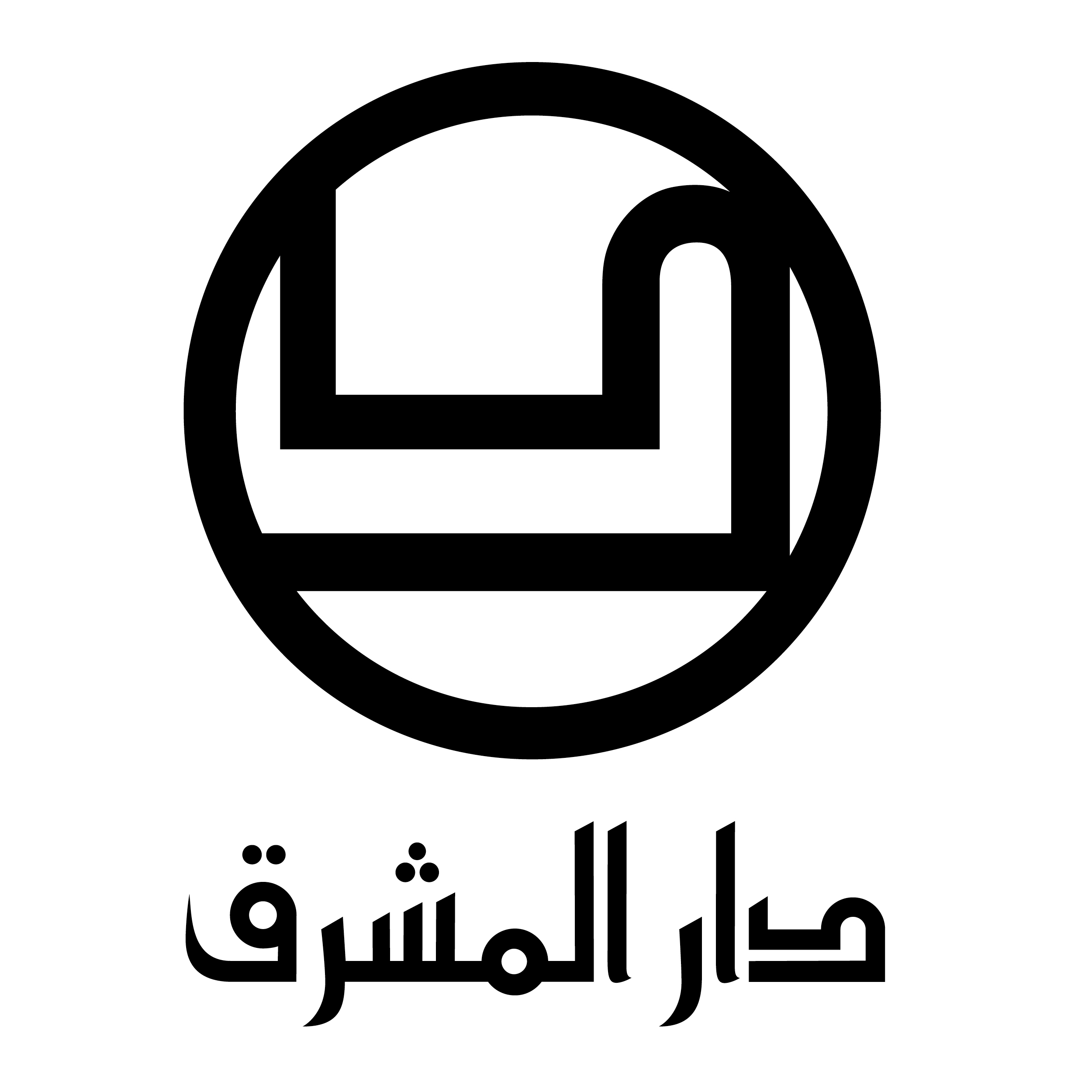

تعليقات 0 تعليق