حَوَرُ عين الجنّة... هل هنَّ نساء... أم أشجار وثمار؟
مقدمة
أجمع الشرّاح المسلمين أنَّ جنَّة الإسلام، هي جنَّة ماديَّة، وفيها جميع أنواع الملذّات: أطعمة فاخرة ومتنوعة، وفيها الراحة الدائمة على أسرّة مريحة مع طقس لطيف ومياه باردة، وغلمان يقومون بالخدمة ويقدمون الشراب للأبرار، وآلاف النساء لكل رجل بارّ أو شهيد، يقمن بتمتيعه في علاقة جنسية دائمة إلى الأبد...
يبدو أنّ مفهوم هذه الجنَّة بعيد كل البعد عن النصوص القرآنية، وكلّ ما استند عليه المفسرون، ليؤكدوا مفهوم الجنة القرآنية المادية، هو شرح غير دقيق، ويستند على نصوص متأخرة... فنساء الجنة كلها من الأحاديث المتأخّرة، فلا علاقة لها بمعاني النصوص القرآنية الكريمة، وبالتالي إن جنّة القرآن الكريم خالية تماما من النساء. والآيات التي استند عليها المفسرون المسلمون ليبرهنوا وجود النساء في الجنة هي، كما سنرى، ثمار وأشجار ونسيم...
لذلك، سنعرض الطريقة التي اعتمدناها، في شرح النصوص، والتي اوصلتنا، في النهاية، الى أن جنة المسلمين، هي جنة روحيَّة بامتياز، وبعد موتنا سنعود إلى الله، وسنرى وجهه الكريم مدى الأبدية! وهل من متعة أكبر ان نصبح لا محدودين لنستطيع مواجهة الله اللامحدود ونتمتع بحبه مدى الأبد؟! ومنهجنا في العمل يعتمد على تفسير القرآن التقليدي للمسلمين، كما يرتكّز على أسس سنعرضها:
الشروح التقليدية الاسلامية بالاستناد الى الحديث النبوي الشريف والشرَّاح. إذ اعتاد المفسّرون المسلمون، من أواخر القرن الثالث الهجري، الاعتماد على الأحاديث النبويّة الشريفة التي يعود أقدمها إلى الجيل الثالث الهجري مع صحيح البخاري (ت 256 هـ)! كما اعتمدوا في تطبيق كلمات وأحداث القرآن على السيرة النبويّة، ولكنّ أقدمها يعود إلى أواخر الجيل الثاني الهجري... لذلك مع احترامنا لعظماء أهل التفسير، فقد بالغوا في الاعتماد على نصوص بعيدة، أقلّه، 200 عام، عن الحدث التاريخي... وللاختصار سنركز على تفسير الطبري (ت 310 هـ) وهو أشهر المفسّرين في كتابه: تفسير جامع البيان في تفسير القرآن، كما سنستعين بغيره لشرح إضافي...
الاعتماد على فهم الكلمة والمواضيع القرآنية من خلال نصّ القرآن نفسه. نفتّش عن وجود الكلمة أو الموضوع، في كلّ نصّ القرآن، ونحاول فهم معناها من خلال مقابلة الكلمات، وجمع النصوص.
العودة إلى الكتاب المقدّس بعهديه القديم والجديد كما إلى الكتب المنحولة المسيحيّة واليهوديّة، التي تسبق القرآن، لفهم النصوص بشكل أوضح.
العودة إلى نصوص آباء الكنيسة مثل أوريجانوس (+254)، أفرام السريانيّ (+373)، وكيريللوس الأورشليمي (+379) ومكاريوس المنحول (+400)، ويوحنّا فم الذهب (+407) وغيرهم من الآباء الذين سبقوا بكتاباتهم ظهور الإسلام.
الاعتماد على التحليل اللغوي لمفردات القرآن في السريانيّة والعبريّة واليونانيّة واللاتينيّة، وغيرها من اللغات، التي عاصرت ظهور الإسلام كما الاستناد على مفردات مشابهة وردت المخطوطات العربيّة المسيحيّة التي تسبق القرآن ومنها مكاريوس المنحول وتعود ترجمته العربيّة، حسب دراستنا، إلى القرن السادس م.
الاستناد على شروحات تور اندريه، وخاصة على تفسير لوكسنبيرغ الذي أحدث ضجة في الأوساط العلمية الغربية والشرقية، خاصة في موضوع الحوريات...
اكتشافنا تطوّر الكتابة العربية عبر تحقيق مخطوطات عربية قديمة من خلال تبدل الاحرف والتنقيط...
وهذه بعض الأمثلة من تنقيط المخطوطات[1]: V: بتجاربها ؛ P: بتجايرها ؛ T: بتجابرها ؛ L¹: بتغايرها[2]. V: وينقض؛ P: وييقط ؛ T: وييقض ؛ L¹: ويسقط[3]. V: بسببهم؛ T: نشبهُم ؛ PL¹: يسبيهم[4]. VPT: يشتهوا ؛ L¹: يشبهوا[5]. VPT: ابتلعوا في؛ L¹: ابتلغوا من[6]. V: عربا؛ PL¹: غربا؛ T: عرايا[7]. V: نرىىهم ؛ P: تزينهم ؛ T: تربّيهم ؛ L¹: تزينها[8]...
وهذه أمثلة من قراءات القرآن الكريم: سَنَدْعُ سَنَدْعُو، فسَأدْعُو، سَتُدْعَى سَيُدْعَى (العلق 18). وَقُرءَانَهُ، وَقُرْآَنَهُ، وَقَرَتَهُ، وَقُرَانَهُ (القيامة 17 و18). عِزَّةٍ، غِرَّةٍ (ص 2). بُشْرًا، نُشُرًا، نُشْرًا، نَشْرًا، نَشَرًا، بُشُراَ، بَشْرًا، بُشْرَى (ص 57) بُشْرًا، نُشُرًا، نُشْرًا، نَشْرًا، نَشَرًا، بُشُراَ، بَشْرًا، بُشْرَى (الفرقان 48 والنمل 63). يَعْرِشُونَ، يَعْرُشُونَ، يُعَرِّشُونَ، يَغْرِسُونَ (ص 137). وَعَزَّرُوهُ، وَعَزَرُوهُ، وَعَزَّزُوهُ (ص 157). سَأُوْرِيكُم، سَأُرِيكُمْ، سَأُورِثكُمْ (ص 145). سَكَتَ، أُسْكِتَ، سُكِّتَ، سَكَنَ (ص 154) عُتِيًّا، عُسِيًّا (مريم 8 و69). نُنَجِّي، نُجِّيَ، يُنَجِّي، يُنَجَّى، نُنَحِّي (مريم 72). وَرِءيا، وَرِئْيًا، وَرِيًا، وَرِيْيًا، وَرِيًا، وَرِيئًا، وَرِياءً، وَزِيًّا (مريم 74). وَأَهُشُّ، وَأَهُسُّ (طه 18). يُجْبَى، تُجْبَى، يُجْنَى (القصص 57). وَابْتَغِ، وَاتَّبِعْ (القصص 77). فَٰرِغًا، فَارِغًا، فَزِعًا، فِرْغًا، قَرِعًا، قَرْعًا، فِزِغًا، فُرُغًا، فَرِغًا (القصص 10). فُزِّعَ، فَزَّعَ، فُزِعَ، فَزَعَ، فُرِّغَ، فَرَّغَ، فُرِغَ، أُفرُقِعَ (سبأ 23). فَاسْتَغَاثَهُ، فَاسْتَعَانَهُ، فَاسْتَعَاثَهُ (القصص 15). أَكْبَرُ، وَأَكْثَرُ (الاسراء 21). جَنَّة، حَبَّةٌ (الاسراء 91). وَلَا أَدرَىٰكُم، وَلَا أَدْرَاكُمْ، وَلَا أَدْرَاُتكُمْ، وَلَا أَدْرَأْتُكُمْ، وَلَا أَدْرِيكُمْ، وَلَأَدْرَاكُمْ، وَلَأَنذَرْتُكُمْ، وَلَا أَنذَرْتُكُمْ (يونس 16). تَبْلُو كُلُّ، نَبْلُو كُلَّ، تَتْلُو كُلُّ (يونس 30). نُنَجِّيكَ، نُنَحِّيكَ (يونس 92). بَقِيَّتُ، بَقِيَّةُ، بَقِيَّهْ، تَقيّةُ (هود 86). وَكَلبُهُم، وَكَالِبُهُمْ وَكَالِئُهُمْ (الكهف 18 و22). بُنيَانَهُم، بِنْيَتَهُمْ، بَنْيَتَهُمْ، بُيوتَهُمْ، بَيْنَهُم (النحل 26). لَنُبَوِّئَنَّهُم، لَنُبِّويَنَّهُمْ، لَنُثْوِيَنَّهُمْ (النحل 41). قَدَّمْتُمْ، قَرَأتُمْ، قرَّبتم (يوسف 48)، يَزِفُّونَ، يَرْفُونَ (الصافات 94). يُؤْمِنُونَ، تُؤْمِنُونَ، تُوقِنُونَ (الجاثية 6).
وهذه بعض الأمثلة من تبدل الاحرف في مخطوطات انجيلية[9]:"قنسرين[10] (وفي قراءة
ثانية: قيسرين ܓܢܤܪ (جناسرت)". "بهاتا[11] (بهذا)" ؛ "بهاتا[12] (بهذا)". "كنّا[13] (قنّا)". "جثمان ، جُسمانَ"[14] . "المظانُّ[15] (المظالُّ) المطان . "الجريال[16] الجريان الحريال" . "ويهدي، ويعدى"[17] ؛ "ويهللون، ويعللون"[18]. "وجلٍ ، رجلٍ"[19] . "اطوارِ ، اطرارٍ"[20] . "موعاته ، سرعانه"[21] . "حِطامِ ، حكام"[22] . "هُلكٍ ، ملكٍ"[23] . "الطورِ، الطَوْدِ"[24] ܛܘܪܐ؛ "الطورِ ، الطَوْدِ"[25] .
أمثلة من قراءات القرآن الكريم في تبدل الاحرف: لَيُزلِقُونَكَ، لَيُزْهِقُونَكَ، لَينفذونَكَ (القلم 51)؛ قَابَ، قَادَ، قَيدَ، قَدْرَ (النجم 9)؛ فَوَكَزَهُ، فَلَكَزَهُ، فَنَكَزَهُ (القصص 15)؛ تَضُرُّونَهُ، تُنْقِصُونهُ (هود 57)؛ أَعْطَيْنَاكَ، أَنْطَيْنَاكَ (الكوثر 1)؛ أَوَمَنْ، أَفَمَنْ (الانعام 122)؛ حِجْرٌ، حِرْجٌ (الانعام 138)؛ لَتُرْدِينِ، لَتُرْدِينِي، لَتُغْوِينِ (الصافات 56)؛ الْفَوْزُ، الرزق (الصافات 60)؛ مَرْجِعَهُمْ، مُنقَلَبَهُمْ، مَصيرهُمْ، منفذهُمْ، مَقِيلَهُمْ (الصافات 68)؛ يَجْتَبِيكَ، يَجْدَبِيكَ (يوسف 6)؛ الرِّجْسَ، الرِّجْزَ (يونس 100)؛ تَلَقَّفُ، تَلَقَّم (الشعراء 45)؛ صَوْمًا، صَمْتًا (مريم 56)؛ يَتَفَطَّرْنَ، يَنْفَطِرْنَ، تَتَفَطَّرْنَ، يَتَصَدَّعْنَ (مريم 90)؛ تَنِيَا، تَهِنَا (طه 42)؛ قُدَّ، قُطَّ، عُطَّ (يوسف 26 و27 و28)؛ النَّاسِ، النَّاتِ (الناس 1-3 و5-6)؛ سَقَرَ، صَقَرَ (المدثر 42)؛ ضَرْبًا، سَفْقًا، صَفْقًا (الصافات 93)؛ سَخَّرَ، صَخَّرَ (لقمان 20)؛ سَابِغَاتٍ، صَابِغَاتٍ (سبأ 11)؛ اسْتَطَاعُوا، اسْطَّاعُوا، اصْطَاعُوا (الكهف 97)؛ تَقْهَرْ، تَكْهَرْ (الضحى 9)؛ وَلَا، فلا (القدر 15)؛ يُؤْفَكُ، يَأْفَكُ، يُؤْفَنُ (الذاريات 9)؛ أَفِكَ، أَفَكَ، أُفِنَ (الذاريات 9)؛ عَائِلًا، عَيِّلًا، عديمًا، غريمًا (الضحى 8)؛
إذًا، سنطبّق هذه القاعدة في تغيير بعض نقاط كلمات قرآنية، وبالاستناد الى القاموس الجديد، اليوناني العربي، بالاشتراك مع الاب فانسان ديبريه، المتخصص في مكاريوس سمعان اليوناني، سنعطي معنى جديد للكلمات وتفسير جديد للنصوص، وبذلك نصل الى معنى ادق للكلمات القرآنية... وهذا شرحنا المبسط:
يشمل موضوع الجنّة والنَّار ثلث الآيات المكّيّة الكريمة تقريبًا، وهذا ما يوجد بكثرةٍ في كتب الصلوات في الكنيسة السريانيّة، وبخاصّة صلوات الرُّهبان. استفاض تور أندريه Tor Andrae في وضع التشابيه بين جنّة القدّيس أفرام والقرآن الكريم، فوضع عشرات النصوص في محاذاة بعضها[26]، لكنه لم يحل لغز الحوريات، بينما لوكسنبيرغ حلّ لغز جميعها، ولكنا لم نتفق مع كل شروحاته، فذكرناه في الشروحات أدناه، وأضفنا شروحاتنا، فلنعرضها:
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorأوّلًا: ”قاصرات“
وردت كلمة: ”قاصرات“[27] ثلاث مرّاتٍ في القرآن الكريم، بينما وردت كلمتان مرادفتان لها: مرّةً وحيدةً ”مقصورات“[28] وأخرى ”عربًا“[29]. يُجْمِع الشرّاح المسلمون، وإمامهم الطبريّ على أنّ معنى: «قاصِراتُ، مقصورات، عُربًا»، هو: «نساءً قصّرن أطرافهنّ علـى أزواجهنّ، فلا يُردن غيرهم، ولا يـمددن أعينهنّ إلـى سواهم، ومتحبّبات متودّدات إلى أزواجهنّ»[30].
والمعنى اللغويّ الدقيق لهذه الكلمات هو: «حانيات، منحنيات، متدليّات، معلّقات»...
ربّما نستطيع فهم هذه الكلمات في العودة إلى الجنّة الإفراميّة. على مثال سفر القضاة، في 9/8-15، الذي شخَّص الأشجار فنصّبت ملكًا فيما بينها[31]، وعلى مثال ابن المقفّع الذي أنطق الحيوانات[32]، وجان دو لا فونتين Jean de la Fontaine الذي شخّص السنديانة والقصبة[33]، أنسن القدّيس إفرام أشجار وثمار وأزهار ورياح الجنّة، فأغصان أشجارها هي التي تنحني وتتدلّى وتعرض ثمارها للبارّ. وما يُغني هذا التفسير هو القرآن نفسه، أي تطابق معنى "قاصرات الطرف" مع «قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ» و«ذُلِّلَتْ قُطُوفَها تَذْلِيلا» «وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ» مع لذا وضعنا نصوص القرآن الكريم بموازاة نصوص الجنّة الإفراميّة لتوضيح المعنى:
«قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ»[34]. أي «يتناول الرجل من فاكهتها وهو نائم»[35]. وأيضًا: «ذُلِّلَتْ قُطُوفَها تَذْلِيلا»[36]، أي «ينالها القائم والقاعد والمضطجع»[37]. «وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ»[38] «أي ثمرُ فواكه الجنّتين قريب في متناول صاحبها لأنّها تدنو منه بحسب رغبته»[39]
«إنّ اليد التي امتدّت تُمِدّ المعوزين إليها تتعطّف أثمار الفردوس»![40] و«هفَّت إليه دوالي الفردوس واحدةً فواحدةً تنيله عنقودها»[41]، و«تقوتهنّ في عدنٍ الأشجارُ»[42]، فـ«الثمار من كلّ طعمٍ في مطال اليد»[43].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorثانيًا: ”الطرف“
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor1- المفسّرون المسلمون
وردت كلمة: ”الطرف“[44] ثلاث مرّات في القرآن الكريم. وأجمع المفسّرون المسلمون على تفسيرها: ”النظر“، فيصبح المعنى كما ذكرنا أعلاه: «نساء قصّرت أطرافهنّ علـى أزواجهنّ، فلا يردن غيرهم، ولا يـمددن أعينهنّ إلـى سواهم»[45].
وهذا بعض من تفاسير القواميس العربيّة: «الطِّرْف من الخيل: الكريمُ العَتِيقُ، الطِّرْفَ الكريم من الناس. والطرَفُ: الناحية من النواحي والطائفة من الشي، والجمع أَطراف. ومن الليل فسَبِّحْ وأَطْراف النهارِ؛ أي الظهر والعصر، أو ساعاته. والأَطْرافُ: الأَصابع. وأَطرافُ الرجلِ: أَخوالُه وأَعمامه وكلُّ قَرِيبٍ له مَحْرَمٍ»[46]. «وأطْرافُ الأرض: أشْرَافُها وعلماؤها»[47]. «والطَّرَفُ، والرجلُ الكَريمُ. والأَطْرافُ: الجَمْعُ»[48]، «والطِرْفُ: الكريمُ من الفتيان»[49].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor2- المعنى الجديد
وجدنا معنًى جديدًا لكلمة: ”الطرف“ في مكاريوس - سمعان:
”الطرف“ حسب اليونانيّ «ἀκροθίνια / akrothinia», [50]. تعني: «الثمر البكر»، الأَطْرافَ[51]؛ وفي المجموعة العربيّة الأولى: «الخَيارَ من الأَوائل والبُكُور»[52].
وهذا ما يوازي القرآن الكريم من نصوص الفردوس الإفراميّ:
«وعندهم (أي الأبرار في الجنّة) قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ (أشجار حانيات/ مدلّيات أثمارها البكر) أترابٌ (رفيقات الإنسان البار)»[53]
«الشهور مقسومة أربع فصول: في الثلاثيّة بواكير الثمر»[54].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorثالثًا: أبكارًا
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor1- المفسّرون المسلمون
يُجمع المفسّرون المسلمون أنّ تعبير: «فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا»[55]، يعني: «فصيّرناهنّ أبكارًا عذارى بعد أن كنّ عَجائِز فِي الدُّنْيا عُمْشًا رُمْصًا»[56] ويبقين «عذارى عند كلّ وطء»[57].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor2- المعاجم العربيّة
«بِكرُ كُلِّ شيء: أَوّله؛ وكُلُّ فَعْلَةٍ لم يتقدّمها مثلها، بِكْرٌ. والباكُورُ من المطر: ما جاء في أَوَّل الوَسْمِيِّ. والباكورة: أَوَّل الفاكهة. بُكْرَةً وبَكَرًا كما تقول سَحَرًا. بَكِّرُوا بالصلاة، أَي قدّموها. والبِكْرُ: الجارية التي لم تُفْتَضَّ. والبِكْرُ المرأَة التي ولدت بطنًا واحدًا، وبِكْرُها ولدها»[58].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor3- التفسير الجديد
استنادًا إلى ما ذكرنا من معاني كلمة ”بكر“ في المعاجم العربيّة، وما عرضنا من معنىً جديدٍ لكلمة
”الطرف“، ربّما نستطيع الاستنتاج أنّ كلمة ”أبكارًا“ هي على الأرجح رديفًا لكلمة ”الطرف“ وهذا ما يوازيها في الجنّة الإفراميّة:
«فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا»[59].
«الأبكارُ تقطف البواكيرَ»[60].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorرابعًا: «لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ»
إنّ هذا التعبير القرآنيّ: «لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ»[61]، الذي ورد مرّتين في القرآن الكريم هو شبيه أو رديف لكلمتي «طرف وأبكار».
إذا عدنا إلى معجم مكاريوس المنحول نرى معنى دقيق لكلمتي: ”طمث“[62] التي ترجمت في 80: ”نجس“[63]، هي في اليونانيّة ”μιαρῶν“ وتعني «نجس ودنس ووسخ». و”جنّ“[64]، ”δαίμονος“، تعني شيطان. ويصبح المعنى: «لَمْ يُدنسهُنَّ/ ينجسهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا شيطان»، أي لا يزلن بكرًا وما مسّهنَّ أحدٌ من بشرٍ أو شياطين. هناك عادات، ولا تزال إلى اليوم، في الإسلام: إذا مسّ الإنسان غيرُ الطاهر مأكولًا أو مشروبًا ما ينجّسه، ولا يصحّ أكله أو شربه بعد ذلك، إنّما هنا كلّ الأثمار بكرٌ وطاهرةٌ وحلالٌ أكلها.
«لَمْ يُدنسهُنَّ/ ينجسهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا شيطان»
«إنّ سيل الأثمار، يتدفّق بالبواكير»[65].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorخامسًا: ”كواعب“
وردت كلمة ”كواعب“[66] مرّة وحيدة في القرآن الكريم. وحسب المعاجم العربيّة: «الكاعِب، وهي الجارية حين يبدو ثَدْيُها للنُهود»[67]. «كَعَبَتِ المرأةُ كعَابةً، وهي كاعِبٌ، إذا نتأ ثَديُها»[68]. لذا يُجمع المفسّرون المسلمون: ”كواعب“ «أي جواري قد تكعّبت أثداؤهنَّ»[69]. ولكنّا إذا عدنا إلى الجنّة الإفراميّة، نرى معنى مختلفًا لـ ”كواعب“، وهذه النصوص في موازاة بعضها البعض:
«إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا»[70]
«ترضعها النسمة لكأنّها ثدي»[71]. «لكأنّ النسمة ثدي مسمّن»[72]. «أمّ ترضع الجميع»[73].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorسادسًا: ”أَتْراب“
وردت كلمة ”أَتْراب“[74] ثلاث مرّات في القرآن الكريم، وهي «جمع ”تريب“، أي رفيق ورفقة»[75].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor1- المفسّرون المسلمون
أجمع المفسّرون المسلمون على معناها المزدوج: رفاق ومن عمر الشباب المتجدِّد. وهذه نصوص المفسّرين بموازاة نصوص الجنّة الإفراميّة، الذين، على الأرجح، عرفوا هذه النصوص:
”أَتْراب“: «سنٌّ واحدة»[76]، «متساويات في العمر»[77]، «ليس فيهنّ عجوز ولا طفلة»[78]، «لهنّ من العمر 33 سنة لا يكبرن عنها أبدا»[79]
«نبت الفردوس... من يذقه تعده الفتوّة»[80]. «وأرجه يعيدك، أيتها الشيخوخة، إلى الطفولة، استنشاقه إلى الشباب»[81] «هناك لا يشيخون»[82].
”أَتْراب“:«متواخيات لا يتبـاغضن، ولا يتعادين، ولا يتغايرن، ولا يتـحاسدن»[83].
«لا حقد فلا غضب لا غشّ فلا هزء. هناك لا يحسدون فهناك لا يبغضون»[84]. «فإنّ أجسادهم، هي بطبعها قلقة ومقلقة، تصبح صافية هادئة»[85].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor2- التفسير الجديد
أنسن القدّيس إفرام الأشجار والأزهار والثمار والرياح، وجعلها كلّها في خدمة البار، إذًا هي رفيقة البار تتبعه وتخدمه وتطعمه، وهذا النصوص في موازاة بعضها البعض:
”أَتْراب“ «جمع ”تريب“، أي رفيق ورفقة»
«والرجل التي عادت المرضى تهرع الأزاهير تكلِّل عقبيها، فيتزاحمن أيّهنَّ تسبق فتلثم مواطئها»![86]
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorسابعًا: عين
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor1- ”عين“ في القرآن الكريم
وردت كلمة ”عين“ في القرآن الكريم في معانٍ كثيرة: حاسّة البصر، 21 مرّة[87]؛ و11 مرّة، نبع مياه[88]؛ ومعنى مجازيّ 15 مرّة[89].
ووردت أربع مرّات، حسب تفسير المسلمين، بمعنى «النساء ذات الأعين الكبيرة السوداء والجميلة»[90]، منها 3 مرّات[91] تلي كلمة ”حور“ إذًا، على الأرجح، هي صفة لحور: «حُور عِين»، إنّما سبقها في مكانين فعل ”زَوَّجْنَاهُمْ“: «وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِين»[92].
كما وردت مرّةً وحيدةً مع «قاصرات الطرف»، وفي مكانٍ آخر وردت، مع «قاصرات الطرف»، كلمة أتراب بدل عين.
لكن مع تعبير: «قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ»[93] والتي يقابلها: «قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أترابٌ»[94]، يرجّح أنّ معنى ”عين“ هو شبيه أو قريب لكلمة ”أتراب“، ولنبدأ بتفصيل الشرح:
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor2- ”عين“ في المعاجم العربيّة
لكلمة ”عين“ معانٍ عديدة نورد هنا بعضها وقد تساعدنا على فهم معناها: «الجاسوس، والدِّينارُ، والسَّيِّدُ، وكبيرُ القَوْمِ، ومَطَرُ أيَّامٍ لا يُقْلِعُ، والناحِيَةُ»[95]. «العين الذهب عامّة، وحقيقة الشيء. والعينة: خيار الشيء، أي أجودُه، جمعها عِين. «عُيُن: أشخاص»[96]، «عينٌ، أي أحد. وبلدٌ قليلُ العينِ، أي قليل الناس. والعَيَنُ: أهل الدار، جماعة. عَيَّنَ الشَّجَرُ: نَضِرَ، ونَوَّرَ»[97]...
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor3- ”عين“ والجنّة الإفراميّة
لوكسنبيرغ، من جهته، يعود بكلمة ”عين“ إلى السريانيّة لتعني صفة كريستاليّة للعنب الأبيض[98]. بعد كل هذا العرض لبعض معانٍ لكلمة ”عين“، نرجّح أنّ كلمة ”عين“ هي صفةٌ لأشجار وثمار وأزهار الجنّة، وليس للنساء. وهذه بعض النصوص بالتوازي مع منظومة الفردوس:
«قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ»[99] أي منوّرة/ نضرة/ أشخاص/ أهل الدار/ جماعة/ خيار/ أجود/ نخبة/ جميلات/ طيّبات/ سليمات/ غاليات.
«جميع أشجار الفردوس موشّحة بالضياء»[100] «ومحاسنه محسودة»[101] «إنّه أفضل من كلّ كنوز المعمورة»[102] «لا يوجد مرآة تعكس جماله ولا ألوان ترسمه»[103] «لم تقوَ الحواس على الإحاطة بكنوزه البهيّة»[104] و«بكثرة ملذّاته»[105] «أزهار تلك الأرض هي أغزر وأروع من نجوم هذه السماء المنظورة»[106]
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor
ثامنًا: حور
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor1- المفسّرون المسلمون
أجمع المفسّرون المسلمون، بالاستناد إلى الأحاديث النبويّة الشريفة، أنّ كلمة ”حور“ وهي جمع حوراء تعود إلى حوريّات الجنّة[107]. واستفاضت الأحاديث النبويّة الشريفة في وصف الحوريّات[108]... فما معنى كلمة ”حور“ حسب المعاجم العربيّة؟
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor2- المعاجم العربيّة
نجد في ما يسمّى بالقراءات الشاذّة في القرآن الكريم، التي هي، على الأرجح، اختلاف نقل الكلمات بسبب أخطاء النسّاخ[109]، قراءة مختلفة أو شاذّة لكلمة ”حور“وهي ”عيس“[110]. لنشرح معنى الكلمتين:
«حور: جمع حوراء، أي البيضاء، امرأَة حَوارِيَّةٌ إِذا كانت بيضاء. والحَوْرُ: البَقَرُ لبياضها. وتَحْويرُ الثياب: تبيضها»[111]. «واحْوَرَّ: ابْيَضَّ»[112].
«عيس: بياض يُخالِطُه شيء من شُقْرة»[113] و«العرب خَصّت بالعَيَسِ الإِبلَ البيضَ»[114] «يخالط بياضها شيء من الشقرة»[115].
إذًا نستنتج أنّ كلمة ”حور“، وبديلتها ”عيس“، تعنيان البياض، لكنّ ”عيس“ تعني بياضًا يميل إلى الشقرة. وهذا ما يرجّح بياض العنب المائل إلى الشقرة عند نضوجه، فهو «كلؤلؤ مكنون»، كون اللؤلؤ مشهور بشكله أي حبّات صغيرة كحبّات العنب.
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor3- لوكسنبيرغ
إنّ كلمة ”حور“، حسب لوكسنبيرغ[116]، إذا عدنا إلى السريانيّة، هي مشتقّة من كلمة ”ܚܘܪܬܐ“ وفي الجمع ”ܚܘܪܐ“ وهي نوع من العنب الأبيض[117]، وما يضفي واقعيّة على تفسيره هو لسان العرب: «أبيض: ضرب من العنب الأبيض في الطائف عظيم الحبّ»[118].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor4- التفسير الجديد مع الجنّة الإفراميّة
في ضوء ما ذكرنا، ربّما نستطيع الاستنتاج أنّ كلمة ”حور“ هي نوع من الفاكهة البيضاء أو المائلة إلى اللون الأشقر لون العنب أو التفّاح الناضج. وهنا «حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي ٱلْخِيَامِ»[119]، هي المرّة الوحيدة التي وردت فيها كلمة ”حور“ من دون كلمة ”عين“. وما ورد في الجنّة الإفراميّة ربّما يرجّح ما استنتجنا:
«حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي ٱلْخِيَامِ» أي عناقيد من فاكهة: عنب أو غيرها معلّقة في الخيام.
«رأيت مظال الصدّيقين مربوطة[120] ܡܓܕܠܢ بالأثمار»[121] «سماؤهم ثمر... غمامة فوق الرؤوس، مظلّة من ثمر»[122].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorتاسعًا: وَزَوَّجْنَاهُمْ
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor1- المفسّرون المسلمون
وردت كلمة ”وَزَوَّجْنَاهُمْ“[123] مرّتين في القرآن الكريم. وأجمع المفسّرون المسلمون أنّ المعنى واضحٌ وهو: زواج حلال بالحوريّات في الجنّة[124].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor2- لوكسنبيرغ
اقترح لوكسنبيرغ [125] حلًا لكلمة ”وَزَوَّجْنَاهُمْ“ عندما غيّر تنقيط الحروف فأصبحت: ”وَرَوَّحْنَاهُمْ“، كون النصّ الأصليّ للقرآن الكريم كان بدون تنقيط، ويصبح المعنى: ”ريَّحناهم“[126]. أي ريَّحناهم بعنب أبيض كالكريستال.
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor3- التفسير الجديد والجنّة الإفراميّة
وجدنا قراءة مختلفة لكلمة ”وَزَوَّجْنَاهُمْ“ وهي: ”وَأَمْدَدْنَاهُمْ“، وكلمة ”أَمْدَدْنَاهُمْ“ استعملت مرّة في القرآن الكريم أمام الفاكهة: «وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ»[127]، ممّا يرجّح أنّ معنى ”وَرَوَّحْنَاهُمْ“ هو أقرب إلى المنطق من ”وَزَوَّجْنَاهُمْ“. ولكن الأهم أنّ المعنى القرآنيّ يصبح متناقضًا إذا استعملنا معنى الزواج: «وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيهَا (منها؟) بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آَمِنِينَ»[128]، إذ كيف نزوِّجهم بحوريّات وفيها كلّ أنواع الفاكهة؟ فهل نقطف الفاكهة من النساء؟ أو من الأشجار؟ ونصوص الجنّة الإفراميّة توضح كيف تهتمّ الأشجار براحة المؤمنين في الجنة:
«وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِين»[129]. أي وروّحناهم (ريّحناهم) بأشجار وأثمار جميلة ولذيذة وهي التي تهتمّ بالبار وتخدمه بينما هو مرتاح ومتمتّع.
«أيّ سيل من طيّبات! فما تصرفك الواحدة حتّى تدعوك الأخرى، على جميعهنّ تتألّق البهجة، من ثمر هذه تأكل ومن شراب تلك ترتوي، وأريج هذه تستنشق»[130].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorعاشرًا: لؤلؤ مكنون
ورد، هذا التعبير: «كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ»[131] و«كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ»[132]، مرّتين في القرآن الكريم. وقد أجمع المفسّرون المسلمون على وصف جمال اللؤلؤ فهي «كالدرّ المحفوظ المخزون في أصدافه»[133]. لكن تعبير «اللؤلؤ أو الدر المكنون» موجود في الجنّة الإفراميّة عند وصف «الورود والأزهار»:
«كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ»[134]، «كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ»[135]
«ܤܝܡܬܐ ܛܡܝܪܐ: لؤلؤ / درّ مطمور/ مكنون»[136].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor
حادي عشر: أزواج مطهّرة
يجمع المفسّرون المسلمون أنّ «الأزواج المطهّرة» هنّ النساء اللواتي لا يحضن في الجنة أبدا، فهنّ دومًا طاهرات، وجاهزات للعمل الجنسيّ في كلّ لحظة[137]. وهذا تفسيرنا بشكلين مختلفين:
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor1- على غرار الملائكة
إنّ كلمة ”مطهّرة“ تعني ”مقدّسة“، مقدّس[138]، طاهر[139]، قدّيس[140]، ἁγίος, saint؛ طاهر[141]، مقدّس[142]، ἱερὸς, sacré. حسب مكاريوس - سمعان. وبالتالي نستطيع المقارنة مع الإنجيل ومع منظومة الفردوس:
«خَالِدِينَ فِيهَا (الجنة) وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ»[143]
«في القِيامَةِ لا الرِّجالُ يَتَزَوَّجون، ولا النِّساءُ يُزَوَّجنَ، بل يَكونونَ مِثلَ الملائِكَةِ (قدّيسين) في السَّمَاء»[144]. «هناك يرتاح الزواج»[145] و«لا يلدون»[146].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor2- أزواج من نبات أو من فاكهة
وردت كلمة زوج وأزواج 81 مرّة في القرآن الكريم. إنّما وردت خمس مرّات لتعني أزواجًا نباتيّة[147]، ووردت مرّة وحيدة لتعني أزواج من فاكهة: «فِيهِمَا (الجنّتين) مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ»[148]. إنّ تعبير «أزواج نباتيّة» أو «أزواج من فاكهة» يبدو غريبا، فعادة نستعمل لفظة ”زوج“ للذكر والأنثى، لثيران البقر، للحمام، للأعمال الحسابيّة...
إذا ربّما الأزواج المطهّرة تعني أزواج الفاكهة، كما ورد أعلاه، لأن سياق النصّ يتكلّم على الفاكهة والأنهار. وما ورد في الجنّة الإفراميّة ربّما يحلّ لغز هذا الأمر الغريب. وهذه هي النصوص:
«وَلَهُمْ فِيها (الجنة) أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ»[149]
«هناك الشهور لا ينضب معين إيلادها. فشهر يحمل الثمر وجاره الزهر»[150]، «من رأى أحشاء حبلى بالأزاهير؟ يمخض الشهر في أوّله، فيولدن فجأة»[151]
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorثاني عشر: غلمان وولدان مخلّدون
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor1- لمحة تاريخيّة
إنّ تعبير: «وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ»[152]، أوقع المفسّرين المسلمين في حيرة، فأجمع غالبيّة المفسّرين المسلمين أنّ المقصود بالغلمان أو الولدان هم الأطفال المتوفّون دون سن الخامسة عشرة، ووظيفتهم هي الخدمة في الجنّة، فهم يطوفون أي يجولون على الأبرار ويقدّمون لهم الخدمات[153]. اعتمد محمّد جلال كشك على مبدأ الجنّة الإسلاميّة المادّيّة ليستنتج أنّ الغلمان جعلهم الله لمتعة الشاذّين جنسيّا، الذين عاشوا الطهارة في هذه الدنيا، وبخاصّة لمن لديهم ميولٌ جنسيّةٌ نحو الأطفال[154]. ربط تور أندريه ريح الجنّة الإفراميّة بالغلمان، فالاثنان يقومان بالخدمة نفسها[155]. أمّا لوكسنبيرغ فعاد إلى ترجمة العهد الجديد المعروفة ܦܫܝܛܬܐ أي البسيطة، واستند إلى كلمتي «ܝܠܕܐ ܕܓܦܬܐ»[156]، وترجمتهما الحرفيّة: «وَلَدُ الجفنة»، لتعنيا: الخمر. ويستنتج أنّ كلمتي «غلمان وولدان» هما ترجمة حرفيّة عن السريانيّة[157].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor2- التفسير الجديد والجنّة الإفراميّة
نستطيع أن نفهم هذه الآيات بشكل مختلف بالمقارنة مع الجنّة الإفراميّة. فالأثمار هي التي تلد بغير انقطاع، وتُقطف كلّ يوم أي إلى الأبد:
«وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا»[158]«وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ»[159]
«إنّ رحم الأثمار تشبه، في نتاجها، معين الزواج يفيض البشر، وشبانا وكهولا أطفالا ولدوا وأجنّة يولدون. ثمارها المتسلسلة تتعاقب حلقاتها تعاقب السلالة البشرية بغير انقطاع»[160].
«يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ»[161]
«إنّ جماعة القدّيسين لممثّلة بالفردوس. فيها، أيّها الإخوة، تقطف، كلّ يوم، الثمرة محيية الجميع، فيها يعتصر العنقود محيي الجميع»[162].
AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorثالث عشر: فُرُش وسُرُر
في المقارنة بين آيات القرآن الكريم ومنظومة الفردوس نفهم أنّ الفرش والسرر هي فرش أعدّتها الأشجار لتكرِّم الأبرار وتريحهم:
«وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ»[163].
«إن شئت أن تترقى الشجرة، تحدّبت أغصانها درجًا أمام قدميك تغريك بالاتكاء إلى صدرها مضطجع أغصانها ذات الظهر المتين الخفيض الحافل المتموج بالأزاهير، للمستغرق فيه كما يكون للطفل الحضن والسرير»[164].
مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ»[165].
«إنّ الأشجار يعظِّمن الصائمين داعيات لهم أن يعرِّجوا إلى منازلهنّ ويحلّوا في خيامهنّ»[166].
خاتمة
إنّ الجنّة القرآنيّة، التي تشبه الجنّة الأفراميّة، في المأكول والراحة، هي انجيلية وروحية بامتياز. فالمؤمن في جنة القرآن:
سيعود الى قلب الله الذي خرج منه: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»[167]، وهذا ما يتطابق مع كلام القديس يوحنا:
إنجيل يوحنّا ورسالته الاولى
القرآن
إنّ المؤمنين لم يولدوا: «لا مِن دَمٍ ولا مِن رَغبَةِ لَحْمٍ ولا مِن رَغبَةِ رَجُل بل مِنَ اللهِ وُلِدوا»[168]. «وكُلُّ مَولودٍ للهِ لا يَرتَكِبُ الخَطيئَة لأَنَّ زَرْعَه باقٍ فيه ولا يُمكِنُه أَن يَخطَأَ لأَنَّه مَولودٌ لله»[169].
«إِنَّا لِلَّهِ»[170]، أي من الله.
«كانَ يسوعُ يَعَلمُ بِأَن قد أَتَت ساعَةُ انتِقالِه عن هذا العالَمِ إِلى أَبيه... وأَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الله، وإِلى اللهِ يَمْضي»[171].
«وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»[172]«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُؤْمِنَةُ[173] (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً[174] مَرْضِيَّةً[175]»[176]
هنا تتوضح طبيعة كينونة الانسان الإلهية في النصين المتقابلين، كلنا خرجنا من الله، واليه قلبه سنعود...
سيضيئ وجهه في حضرة الله: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ»[177]، وهذا ما يتماشى مع المفهوم المسيحي، وهذه النصوص في مقابل بعضها البعض:
الإنجيل ورؤيا يوحنّا
القرآن
«والصِّدِّيقونَ يُشِعُّونَ حِينَئذٍ كالشَّمْسِ في مَلَكوتِ أَبيهِم»[178].
«وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ»[179]
«ويُشاهِدونَ وَجهَ الله»[180]، «لأَنَّنا سنُصبِحُ أَشباهَه، وسَنَراه كما هو»[181]
«إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ»[182]
إذا، إنّ الصورة التي تجلى فيها المسيح أمام تلاميذه: «فأَشَعَّ وَجهُه كالشَّمس، وتَلألأَت ثِيابُه كالنُّور»، (متى 17/2)... والتي كانت صورة مسبقة لما سيحدث للمؤمن في الجنة... والقرآن أيضا تخطى مفهوم الجنة الأفرامية الى التمتع برؤية وجه رب العالمين...
فهل نترك معاينة الله وجهًا لوجه لنتمتّع مع حوريّات للأبد؟!
ملاحظة: إنّ الكون ضخم جدا فيحتوي على ما يزيد عن 500 مليار مجرَّة، وكلّ مجرَّة تحتوي على ما يزيد عن 500 مليار كوكب... إذا إنّ الكون هو لا محدود... فهل من الممكن ان يكون خالقه محدودا؟ لذلك حتما ستكون طبيعتنا غير مادية، تشبه طبيعة الله، لنستطيع أن نتمتع برؤيته. وهذا يتطابق مع ما قاله القديس شربل: «الإنسان مخلوق كَوْنيّ، حدوده النور، وليس مخلوق أرضي، حدوده التراب والماء»[183].
AnchorAnchorAnchorAnchorالمصطلحات
80 المجموعة العربيّة الأولى أي مجموعة المخطوطات التي تحمل اسم القدّيس سمعان، مخطوطات: فاتيكان عربيّ 80، وباريس عربيّ 149، وفاتيكان عربي 70، ودير الشرفة، رحماني 12، ولندن شرقي 2322 و4092...
84 المجموعة العربيّة الثانية، أي مجموعة المخطوطات التي تحمل اسم القدّيس مقاريوس، فاتيكان عربيّ 84، ومخطوطات سيناء الثلاث: 356 و358 و446...
مقالة، قول مختصر، مسألة أي مستقاة من 80 أي المجموعة العربيّة الأولى.
ميمر أي مستقاة من 85، أي المجموعة العربيّة الثانية.
I مقدمة S³، وهو نصّ مختلف عن بقيّة المخطوط.
L¹ مخطوط لندن شرقيّ 4092.
L² مخطوط لندن شرقيّ 2322.
M مخطوط لبنان، دير الشرفة، رحماني 12.
P مخطوط باريس عربيّ 149.
S¹ مخطوط سيناء عربيّ 356.
S² مخطوط سيناء عربيّ 358.
S³ مخطوط سيناء عربيّ 446.
T مخطوط فاتيكان عربيّ 70.
V مخطوط فاتيكان عربيّ 80.
W مخطوط فاتيكان عربيّ 84.
المفسّرون المسلمون: التستريّ (ت 283هـ)، الهواريّ (ت القرن 3هـ)، الطبريّ (ت 310هـ)، الزمخشريّ (ت 538هـ)، الطبرسيّ (ت 548هـ)، الرازيّ (ت 606هـ)، القرطبيّ (ت 671هـ)، البيضاويّ (ت 685هـ)، ابن كثير (ت 774هـ)، السيوطيّ (ت 865هـ)، الشوكانيّ (ت 1250هـ) www.altafsir.com/IndexArabic.asp
القواميس العربيّة: لسان العرب، مقاييس اللغة، الصحاح في اللغة، العباب الزاخر والقاموس المحيط http://baheth.info/
الكتب الإسلاميّة مثل كتب: السير النبويّة والأحاديث النبويّة الشريفة والتاريخ والجغرافيا من خلال الإنترنيت، مثل المكتبة الشاملة وموقع الورّاق.
المصادر والمراجع
أوّلًا: المخطوطات
مخطوط فاتيكان عربيّ 80، نُسخ في الجيل الثالث عشر، عرَّفه Strothmann شتروتمان بـ: V.
مخطوط باريس عربيّ 149، نُسخ سنة 998م. عرفّناه بـ: P.
مخطوط فاتيكان عربيّ 70، نُسخ بين القرنين الخامس والسادس عشر. عرَّفه Strothmann شتروتمان بـ: T.
مخطوط دير الشرفة - لبنان، رحماني 12، كرشونيّ، نُسخ سنة 1660م، وقد عرفّناه بـ: M. نَسخ هذا الكتابَ قس جرجس ابن افرام من قرية بان من جبل لبنان.
مخطوط لندن شرقيّ 2322. كرشونيّ، نُسخ في القرن الثامن عشر، وقد عرفّناه بـ: L². خطّه مقرؤءٌ مقبولٌ وورقه جيّد. عدد صفحاته 199 ورقة. كتب بالخط الكرشونيّ السيرتو.
مخطوط لندن شرقيّ 4092. كرشونيّ، نُسخ عام 1803، وقد عرفّناه بـ: L¹. كتب بالخطّ الكرشونيّ السيرتو.
مخطوط فاتيكان عربيّ 84. نُسخ عام 1055، عرَّفه Strothmann شتروتمان بـ: W. ورق المخطوط من الجلد.
مخطوط دير القدّيسة كاترينا - سيناء، عربيّ 356، نُسخ عام 1182م، عرفّناه بـ: S¹. ناسخه ملاتى الاغنستس من دير السيده ارشايا... وكتب برسم الراهب انبا سابا الطورسيني.
مخطوط دير القدّيسة كاترينا - سيناء، عربيّ 358. نُسخ في القرن الثاني عشر عرفّناه بـ: S².
مخطوط القدّيسة كاترينا - سيناء، عربيّ 446. نُسخ في القرن الثالث عشر، عرفّناه بـ: S³.
انجيل لوقا، مخطوط ليدن شرقي 2378.
انجيل لوقا، مخطوط فاتيكاني عربي 17، نسخه، عام 1009م، حمد ان علي حامد.
انجيل لوقا، مخطوط فاتيكاني عربي 18، نسخ عام 993م في القاهرة.
الانجيل، مخطوط رقم 432، الدبسي، بيروت، المكتبة الشرقية.
الانجيل، مخطوط عبد يشوع الصوباوي 431، بيروت، المكتبة الشرقية.
مخطوطات دير القديسة كاترينا – سيناء، مباشرة على موقع الانترنيت: http://www.e-corpus.org
المخطوطات القرآنية موجودة على الانترنيت corpuscoranicum.de بالاضاقة الى مصاحف القاهرة (نسخة الجامع الحسيني) واسطمبول (نسخة متحف طوب قابى سرايى) وطشقند (نسخة طشقند مكملة) وبعض أوراق من مصاحف صنعاء ومصاحف بالخظ الحجازي في مكتبة باريس الوطنية ومكتبة لندن.
ثانيًا: المصادر
القرآن الكريم
الكتاب المقدّس، العهد القديم والعهد الجديد، دار المشرق، بيروت، 1988.
الكتاب المقدّس العهد الجديد، كلّيّة اللاهوت الحبريّة، جامعة الروح القدس، الكسليك، المطبعة البولسيّة، جونيه، لبنان، ١٩٩٢.
إفرام السريانيّ، القدّيس، منظومة الفردوس، ترجمة الأبوين روفائيل مطر ويوحنّا الخوند، الكسليك، لبنان، 1983.
ثالثًا: المراجع
إسكندر، الاب حنا، القديس شربل ... كما شهد معاصروه، لبنان، 2007.
الحجّة الشيخ محمّد السبزواري النجفيّ، إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1419هـ - 1998
كشك، محمّد جلال، خواطر مسلم في المسألة الجنسيّة، بأمر القضاء، مكتبة التراث الإسلاميّ، القاهرة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
مكرم، أحمد مختار عمر وأبي السيد معجم القراءات القرآنيّة، 8 أجزاء، الكويت، 1988
منّا، قاموس سريانيّ - عربيّ.
Andrae, Tor, Les Origines de l’Islam et Le Christianisme, traduit de l’allemand par Jules Roche , Coll. «Initiation à l’Islam», VIII, lib. D’Amérique et d’Orient, Adrien-Maison Neuve, 1955.
Luxemberg, Christophe, The Syro-Aramaic Reading of the Koran: A Contribution to the Decoding of the Language of the Qur'an, 2007.
* دكتور متخصِّص بالتاريخ، وأستاذ مادّة التاريخ واللغات القديمة في الجامعة اللبنانيّة. نشر عشرات الكتب وعددًا من المقالات البحثيّة؛ فَهْرَسَ وحقَّق حوالى خمسين ألف وثيقةٍ وعشر مخطوطات. اشترك في عددٍ من البرامج التلفزيونيّة والإذاعيّة.
[1] الأحرف اللاتينيّة هي اختصار لمخطوطات مكاريوس العربيّة. والأمثلة من المقالة الثانية من المجموعة العربيّة الأولى.
[2] العنوان.
[3] 1/5.
[4] 1/4.
[5] 2/5.
[6] 2/6.
[7] 5/9.
[8] 6/2.
[9] ترجمة قديمة للإنجيل، وأقدم نسخة تعود للعام 383هـ، وصل الينا منها نسخ ثلاث: 17 و18 فاتيكان عربي، و561 ليدن شرقي.
[10] مت 14/34
[11] يو 14/25
[12] يو 15/11
[13] مت 13/31-32
[14] لو 24/3
[15] يو 14/2
[16] لو 5/9
[17] لو 1/17
[18] لو 2/20
[19] لو 12/5
[20] لو 9/15
[21] لو 6/37
[22] لو 16/9
[23] لو 17/33
[24] لو 7/32
[25] لو 21/21
[26] Cf. Tor Andrae, Les Origines de l’Islam et Le Christianisme, traduit de l’allemand par Jules Roche, Coll. «Initiation à l’Islam», VIII, lib. D’Amérique et d’Orient, Adrien-Maison Neuve, 1955, p. 151- 161.
[27] سورة 37 (الصّافات)، الآية 48؛ سورة 38 (ص)، الآية 52؛ سورة 55 (الرحمن)، الآية 56.
[28] سورة 55 (الرحمن)، الآية 72.
[29] سورة 56 (الواقعة)، الآية 37.
[30] الطبريّ، www.altafsir.com/IndexArabic.asp.
[31] أنظر قضاة 9/ 8-15.
[32] أنظر، عبدالله بن المقفّع، كليلة ودمنة.
[33] Cf. Jean de la Fontaine; les Fables de la Fontaine.
[34] سورة 69 (الحاقة)، الآية 23.
[35] الطبريّ، www.altafsir.com/IndexArabic.asp.
[36] سورة 76 (الإنسان)، الآية 14.
[37] أنظر تفسير الجلالين، المرجع السابق، سورة 76 (الإنسان)، الآية 14.
[38] سورة 55 (الرحمن)، الآية 54.
[39] الحجّة الشيخ محمّد السبزواري النجفيّ، إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1419هـ - 1998م، ص538.
[40] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 7/17.
[41] المرجع نفسه، 7/ 18.
[42] المرجع نفسه، 7/20.
[43] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 9/4.
[44] سورة 37 (الصّافات)، الآية 48؛ سورة 38 (ص)، الآية 52؛ سورة 55 (الرحمن)، الآية 56.
[45] الطبريّ، www.altafsir.com/IndexArabic.asp.
[46] لسان العرب، http://baheth.info.
[47] العباب الزاخر، http://baheth.info.
[48] القاموس المحيط، http://baheth.info.
[49] الصّحّاح في اللغة، http://baheth.info.
[50] GL 1, 7, 11.
[51] 84، الرسالة الكبرى، 7/11.
[52] 80، الرسالة الكبرى، 7/11، وهذا ما ينسجم مع المعنى اليونانيّ: بكر الثمر.
[53] سورة 38 (ص)، الآية 52.
[54] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 10/7.
[55] سورة 56 (الواقعة)، الآية 36.
[56] الطبريّ، www.altafsir.com/IndexArabic.asp.
[57] إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن، المرجع السابق، ص540.
[58] لسان العرب، http://baheth.info.
[59] سورة 56 (الواقعة)، الآية 36.
[60] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 7/9.
[61] سورة 37 (الصّافات)، الآية 48؛ سورة 55 (الرحمن)، الآية 56.
[62] W: 1/3/3؛ 4/2/5؛ 9/17؛ 13/11.
[63] V: 36/9/17.
[64] W: 1/2/4؛ 2/2/4؛ 12/10.
[65] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 10/13.
[66] سورة 78 (النبأ)، الآية 33.
[67] الصّحّاح في اللغة، http://baheth.info.
[68] مقاييس اللغة، http://baheth.info.
[69] إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن، المرجع السابق، ص 588.
[70] سورة 78 (النبأ)، الآيات 31-33.
[71] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 9/12.
[72] المرجع نفسه، 11/1.
[73] المرجع نفسه، 9/14.
[74] سورة 38 (ص)، الآية 52؛ سورة 56 (الواقعة)، الآية 37؛ سورة 78 (النبأ)، الآية 33.
[75] لسان العرب، http://baheth.info.
[76] الطبريّ، www.altafsir.com/IndexArabic.asp.
[77] ابن كثير، www.altafsir.com/IndexArabic.asp.
[78] إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن، المرجع السابق، ص 460.
[79] البخاريّ والزمخشريّ، www.altafsir.com/IndexArabic.asp.
[80] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 7/21.
[81] المرجع نفسه، 7/10.
[82] المرجع نفسه، 7/22.
[83] الطبريّ، www.altafsir.com/IndexArabic.asp.
[84] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 7/11.
[85] المرجع نفسه، 12/7.
[86] المرجع نفسه، 7/17.
[87] سورة 3 (آل عمران)، الآية 13؛ سورة 5 (المائدة)، الآيتان 45 (مرتين) و83 سورة 7 (الأعراف)، الآيات 116 و179 و195؛ سورة 8 (الأنفال)، الآية 44 (مرتين)؛ سورة 9 (التوبة)، الآية 92؛ سورة 11 (هود)، الآية 31؛ سورة 12 (يوسف)، الآية 84؛ سورة 15 (الحجر)، الآية 88؛ سورة 18 (الكهف)، الآية 101؛ سورة 20 (طه)، الآية 131؛ سورة 54 (القمر)، الآية 37؛ سورة 90 (البلد)، الآية 8.
[88] سورة 2 (البقرة)، الآية 60؛ سورة 7 (الأعراف)، الآية 160؛ سورة 18 (الكهف)، الآية 86؛ سورة 55 (الرحمن)، الآيتان 50 و66؛ سورة 76 (الإنسان)، الآيتان 6 و18؛ سورة 78 (سبأ)، الآية 12؛ سورة 83 (المطفّفين)، الآية 28؛ سورة 88 (الغاشية)، الآيتان 5 و12.
[89] سورة 11 (هود)، الآية 37؛ سورة 18 (الكهف)، الآية 28؛ سورة 19 (مريم)، الآية 26؛ سورة 20 (طه)، الآيتان 39 و40؛ سورة 21 (الانبياء)، الآية 61؛ سورة 23 (المؤمنون)، الآية 27؛ سورة 25 (الفرقان)، الآية 74؛ سورة 28 (القصص)، الآيتان 9 و13؛ سورة 32 (السجدة)، الآية 17؛ سورة 33 (الأحزاب)، الآية 51؛ سورة 52 (الطور)، الآية 48؛ سورة 54 (القمر)، الآية 14؛ سورة 102 (التكاثر)، الآية 7.
[90] الطبريّ، www.altafsir.com/IndexArabic.asp.
[91] سورة 44 (الدخان)، الآية 54؛ سورة (الطور)، الآية 20؛ سورة 55 (الرحمن)، الآية 22.
[92] سورة 44 (الدخان)، الآية 54؛ سورة (الطور)، الآية 20.
[93] سورة 37 (الصافات)، الآية 48.
[94] سورة 38 (ص)، الآية 52.
[95] القاموس المحيط، http://baheth.info.
[96] لسان العرب، http://baheth.info.
[97] الصحاح في اللغة، http://baheth.info. هل نستطيع الاستنتاج أن «أشجار عِين» تعني: أشجار نضرة ومنوّرة، وبذلك يتطابق مع أشجار الفردوس الإفراميّ ومع المعنى القرآنيّ العام؟
[98] Cf. Christophe Luxemberg, The Syro-Aramaic Reading of the Koran: A Contribution to the Decoding of the Language of the Qur'an, 2007, p. 260- 265.
[99] سورة 37 (الصافات)، الآية 48.
[100] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 3/15.
[101] المرجع نفسه، 4/ 7.
[102] المرجع نفسه، 4/ 8.
[103] المرجع نفسه، 4/ 9.
[104] المرجع نفسه، 6/ 2.
[105] المرجع نفسه، 6/ 3.
[106] المرجع نفسه، 1/ 9.
[107] أنظر صحيح البخاريّ، صحيح مسلم...، www.altafsir.com/IndexArabic.asp.
[108] أنظر الطبريّ، الزمخشريّ، ابن كثير...، www.altafsir.com/IndexArabic.asp.
[109] أنظر الأب حنّا اسكندر، القراءات الشاذّة في القرآن الكريم على ضوء قراءات مكاريوس المنحول، مقالة مهداة لتكريم الأب جوزف القزي، قيد النشر.
[110] أحمد مختار عمر وأبي السيد مكرم، معجم القراءات القرآنيّة، 8 أجزاء، الكويت، 1988، ج6، ص143.
[111] لسان العرب، http://baheth.info.
[112] القاموس المحيط، http://baheth.info.
[113] الصحّاح في اللغة، http://baheth.info.
[114] مقاييس اللغة، http://baheth.info.
[115] الصحّاح في اللغة، http://baheth.info.
[116] Cf. Luxemberg, op. cit., p 260- 265.
[117] منّا، قاموس سريانيّ - عربيّ، ص246-247.
[118] لسان العرب، http://baheth.info.
[119] سورة 55 (الرحمن)، الآية 72.
[120] .حسب الكلمة السريانيّة ܡܓܕܠܢ ممكن أن يكون المعنى: كفاكهة مجدّلة على طريقة عناقيد من تفّاح او غيرها من الفاكهة، أو كجدائل البصل أو الثوم، أو الثمار المقدّدة كالتين وغيره... المعروفة في العادات القرويّة القديمة مؤونة للشتاء.
[121] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 5/6.
[122] المرجع نفسه، 9/5.
[123] سورة 44 (الدخان)، الآية 54؛ سورة (الطور)، الآية 20.
[124] أنظر على سبيل المثال: الطبريّ، الزمخشريّ، الطبرسيّ، www.altafsir.com/IndexArabic.asp.
[125] Cf. Luxemberg, op. cit., p 250- 252.
[126] لسان العرب، http://baheth.info.
[127] سورة 52 (الطور)، الآية 22.
[128] سورة 44 (الدخان)، الآية 54- 55.
[129] سورة 44 (الدخان)، الآية 54؛ سورة (الطور)، الآية 20.
[130] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 9/6.
[131] سورة 52 (الطور)، الآية 24.
[132] سورة 56 (الواقعة) ، الآية 23.
[133] إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن، المرجع السابق، ص540.
[134] سورة 52 (الطور)، الآية 24.
[135] سورة 56 (الواقعة) ، الآية 23.
[136] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 7/21.
[137] أنظر على سبيل المثال: الطبريّ، الزمخشريّ، الطبرسيّ...، www.altafsir.com/IndexArabic.asp.
[138] 84 : 1/2/3؛ 80: 36/1/3؛ 2/1/2؛ 2/3؛ 4/1.
[139] 84 : 1/1/3؛ 2/1؛ 2/2؛ 4/1؛ 80: 36/1/2؛ 2/2؛ 3/3؛ 3/11و12؛ 4/1.
[140] 84: 1/3/3؛ 3/11 و12؛ 41.
[141] 84: 1/2/1؛ 3/9.
[142] 80: 36/2/1؛ 3/9؛ 6/1 و5.
[143] سورة 3 (آل عمران)، الآية 15.
[144] متّى 22/30.
[145] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 7/8.
[146] المرجع نفسه، 7/22.
[147] سورة 20 (طه)، الآية 53؛ سورة 22 (الحج) 5؛ سورة 26 (الشعراء)، الآية 7؛ سورة 31 (لقمان)، الآية 10؛ سورة 50 (ق)، الآية 7.
[148] سورة 55 (الرحمن)، الآية 52.
[149] سورة 2 (البقرة)، الآية 25؛ وسورة 4 (النساء) ، الآية 57.
[150] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 10/6.
[151] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 10/9.
[152] سورة 2 (البقرة)، الآية 25؛ وسورة 4 (النساء) ، الآية 57.
[153] أنظر البخاريّ، الطبريّ، الزمخشريّ، الطبرسيّ...، www.altafsir.com/IndexArabic.asp.
[154] أنظر محمّد جلال كشك، خواطر مسلم في المسألة الجنسيّة، بأمر القضاء، مكتبة التراث الإسلاميّ، القاهرة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
[155] Cf. Tor Andrae, op. cit. p. 153.
[156] مرقس 14/25.
[157] Cf. Luxemberg, op. cit., p 184- 191.
[158] سورة 76 (الانسان)، الآية 19.
[159] سورة 52 (الطور)، الآية 24.
[160] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 10/12.
[161] سورة 56 (الواقعة)، الآيات 17-19.
[162] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 6/8.
[163] سورة 56 (الواقعة)، الآية 34.
[164] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 9/3.
[165] سورة 52 (الطور)، الآية 20.
[166] منظومة الفردوس، المرجع السابق، 7/16.
[167] سورة 2 (البقرة)، الآية 156.
[168] يو 1/13.
[169] 1 يو 3/ 9.
[170] سورة 2 (البقرة)، الآية 156.
[171] يو 13/ 1و3.
[172] سورة 2 (البقرة)، الآية 156.
[173] في الأصل: الْمُطْمَئِنَّةُ أي المؤمنة. أصلها من آمن وأمّن، ومنها اتمأن= اطمأن.
[174] اسم فاعل.
[175] اسم مفعول.
[176] سورة 89 (الفجر)، الآيتان 26-27.
[177] سورة 75 (القيامة)، الآيتان 22-23.
[178] مت 13/43.
[179] سورة 75 (القيامة)، الآية 22.
[180] رؤ 4/22.
[181] 1 يو 3/2.
[182] سورة 75 (القيامة)، الآية 23.
[183] الاب حنا إسكندر، القديس شربل... كما شهد معاصروه، لبنان، 2007، ص231.
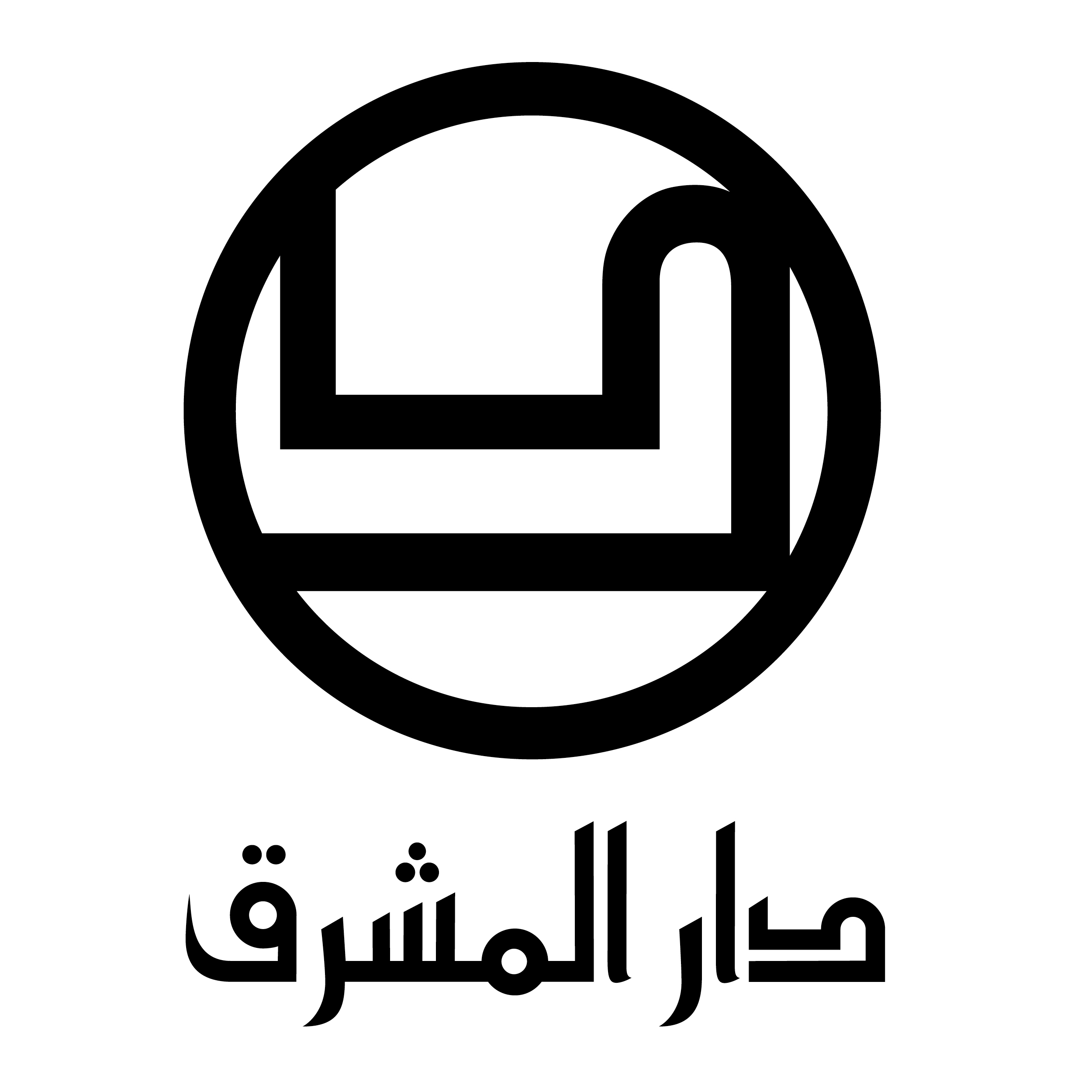

تعليقات 0 تعليق