الهويَّة الفنيَّة المتفرِّدة ما بين الصناعة والتمرُّد على التوريث
لا شكَّ في أنَّ الفنَّ، مازال حتَّى يومنا هذا، مسربَ الرحمةِ التي تليِّن قسوة الواقع، وتُذهب الوحشةَ عن قلوب المتألِّمين فيه؛ هذا الفنُّ الذي وُجد، كما عبَّر فنسنت فان غوغ[1] Vincent Van Gogh يومًا، لمواساة أولئك الذين كسَرَتهم الحياة. فهل لنا أن نتخيَّل الحياة، وقد غاب الفنُّ عن ناسها، عن ساحاتها وغرفها، عن متاحفها ومسارحها، وغامَ عن كلِّ ما فيها؟
لو حصل ذلك في يومٍ لا نريده أن يأتي، فستتراجع لغة الحوار، وسيعلو الصراخ، ويسود التعصُّب، وستذبل الذائقة، ويصير الرديء مألوفًا، والسطحيُّ مقبولًا، وسيتآكل بهاء الحياة كتآكل جدارٍ قديم أُهملت زخرفته. فالفنُّ لم يكن يومًا نظامَ دعم للحياة، بل هو الحياة بذاتها، وفقدانُه يُفضي إلى تذاوبِ المعنى، وانحدار الوعي وتردِّيه، حيث تفقد المجموعات البشريَّة مرآتها، وتتلاشى ملامحها في حَمأة النسيان، ويصير التاريخ فاقدَ اللون، ممسوحَ الهويَّة.
ومثل هذا الحديث عن الفنِّ، يستدعيه حدثٌ حزين هزَّ وجدان الإنسان اللبنانيِّ والعربيِّ، وربَّما العالميِّ، في شهر تمُّوز الماضي، تمثَّل في موت "زياد الرحباني". فالمتأمِّل في الظاهرة المجتمعيَّة الثقافيَّة التي أحدثها موت هذا الفنَّان الكبير، لا بدَّ سيتوقَّف عند جملة من المسائل قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنَّها في أعماقها تحمل الكثير من الإشارات والدلالات التي تستدعي منَّا حسن الاستقراء لها، والتوقُّف عند العِبر المستفادة منها.
أولى تلك المسائل تمثَّلت في تقابلِ الغياب المادِّيِّ لزياد/ الجسد، بحضورٍ معنويٍّ طاغٍ لروح الفنَّان التي سكنته زمنًا، والتي تجلَّت إبداعاتٍ فنيَّة شتَّى، وكشوفات متواليةً، برزت منها: مجموعاتُ ألحانٍ تجديديَّة متنوِّعة، مسرحيَّاتٌ اجتماعيَّة هادفة مطبوعة بطابع التهكُّم والسخرية، كتاباتٌ صحافيَّة ناقدة لاذعة للواقعَين السياسيِّ والاجتماعيِّ في البلاد، وأغانٍ واقعيَّة/ رمزيَّة معاصرة، تمكَّن بوساطتها من نقل السيِّدة فيروز من طقس غنائيٍّ محبَّب مستأنَس، عشقَه جمهور لبنان والعالم العربيِّ، إلى طقس غنائيٍّ جديد لا يشبهه، تباينت الآراء حوله، وأصدر بعض أصحابها أحكامًا قاسية بحقِّه، إلَّا أنَّ معظمها انتهى إلى استملاح الطقس الجديد، وإلى استجادة مغايرته.
والمسألة الثانية التي تستدعي الإشارة إليها، تتبلور في علاقة الإنسان بظاهرة "الفقد" في الحياة؛ فالإنسان لا يني يتعامل مع ما يحيط به، ومن يدور في مَداره، بحسبانه ثابتًا مقيمًا لن يطاله غياب، ومتى طاله مثل هذا النوع من الغياب، وجد نفسه منغمسًا في حالة من الإغراق الوجدانيِّ التفاعليِّ مع الحالة المستجدَّة، وكأنَّه استيقظ من سباتٍ ما، فتنبَّه إلى منزلة ما كان بين يديه وحواليه، واكتشف أهمِّيَّته الفائقة بالنسبة إليه، ولربَّما وجدناه يسبح في عوالم من التأسِّي ولوم الذات، على تقصيرٍ يفترض أنَّه ارتكبه، أو على تغافلٍ مارسه في حقِّه، وأنَّ عليه السعي الحثيث للتعويض عنه، والتكفير عن ذنبه المفترض.
هكذا نفهم كيف اكتسحت أخبار هذا الفنَّان المبدع كلَّ وسائل التواصل الاجتماعيِّ على تنوُّع أشكالها وأساليبها، وانغمست في تغطيتها جلُّ قنواتِ الإعلام المرئيِّ والمسموع مُدليةً بإسهاماتها ومقالاتها، ينهض بها معجبون، محبُّون، أقرباء وأصدقاء، مقرَّبون أو عابرون، أدباء أو متذوِّقون للأدب وللفنِّ، بالإضافة إلى ثلَّة من النقَّاد اللبنانيِّين والعرب، عبَّروا جميعهم عن فجيعة عميقة، وعن يقظةٍ وانتباه إلى قيمة فنَّان حقيقيٍّ كان حتَّى الأمس القريب، يحيا في عاصمة الوطن، في شارعٍ من شوارعها الضاجَّة بالحياة، وربَّما على مقربة من سُبلٍ يعبرونها نهارًا أو في المسايا، يتنفَّسون ذرَّات الهواء التي يتنفَّسها، ويتناولون الأطعمة التي قد يأكل منها، من دون أن يخطر في بال الكثيرين منهم أن يقوموا بزيارته، أو حتَّى بمجرَّد السؤال عنه.
أمَّا المسألة الثالثة فتتمثَّل في أنَّ غياب زياد قد استحضر، بقوَّة، حقيقةً مؤكَّدة ومعروفة منذ زمن، تقول لنا ببساطة إنَّ الفنَّ ليس ترفًا، بل هو جوهر الوجود الإنسانيِّ وهويَّته، حتَّى ولو بدا هذا الفنُّ أحيانًا مسكونًا بالوهم، أو ابنًا شرعيًّا له يمارسه عبر فعل التخييل، ليعبِّر من خلاله عن أحلام الناس وآلامهم، ويمنحهم صوتًا حين يخفت الكلام، سعيًا إلى التخفُّف من وطأة العيش عندما يقسو، وذلك عبر الفسحات النديَّة التي يجترحها لنفوسهم، ما يصيِّره ضرورة حتميَّة، ومطلبًا كيانيًّا يذكِّرنا بما كان يذهب إليه الكاتب الفرنسيُّ غوستاف فلوبير Gustave Flaubert[2] من أنَّ الوهم ضروريٌّ كالخبز... فلا أحد يحتمل الحقيقة طوال الوقت.
أمَّا المسألة الأخيرة التي لا بدَّ من التوقُّف عندها فهي قضيَّة صناعة الهويَّة المتفرِّدة، والتمرُّد على وراثتها. لقد صنع زياد الرحباني هوِّيَّته الفنيَّة حين أصغى إلى صوته الرافض للتكرار، وعندما فرَّ من القولبة ومن الركون إلى النهج الذي تمَّ تصنيعه له، منذ ما قبل ولادته، من خلال ما عُرف بظاهرة "الأخوين رحباني" التي توَّجت اللقاء الفنِّيَّ الإبداعيَّ ما بين فيروز وعاصي الرحباني تحديدًا، فإذا بالابن الموهوب يختار الطريق الوعر مع أنَّ الطريق المعبَّد كان منبسطًا أمامه، وملء يديه وأذنيه وعينيه.
تمرَّد زياد على النهج الرحبانيِّ، فنجح وأخفق، وقال العاديَّ أحيانًا، وغالبًا ما أبدع، وانتُقد وهوجم، إلَّا أنَّه في كلِّ هذه الحالات وجد جمهورًا فتيًّا شابًّا انحاز إليه بقوَّة، وانتصر لمسار فنِّه، وقد استشعر أفراده في أنفسهم انجذابًا صادقًا إليه، لأنَّه كان شفَّافًا وحقيقيًّا عكَس أفكارهم وأحلامهم، فتجلَّى مرآةً مجلوَّة لأرواحهم المتعبة من العصبيَّات والطائفيَّة، ومن الانقسامات والصراعات المُشينة التي كانت تقتات الأنفس والعقول.
لقد تجاوز زياد كونه فنَّانًا يهوى الموسيقى التجديديَّة، والمسرح الملتزم الذي أنتج الواقع اللامعقول، ليتحوَّل صوتًا معبِّرًا عن هموم كثير من الشباب اللبنانيِّ والعالم العربيِّ، لا سيَّما وهو يوظِّف في مسرحه ذاك لغة عامِّيَّة مباشرة، اكتست بالسخرية اللاذعة، فكَّكَ بوساطتها التناقضات السياسيَّة والاجتماعيَّة والطائفيَّة المعقَّدة، والواقع المعيشيَّ الملتبِس، متمكِّنًا بذلك من تحطيم الحواجز، ومشرِّعًا الباب أمام جيل جديد من الفنَّانين والإعلاميِّين، اندفعوا يعبِّرون، بحرِّيَّة، عن تحدِّيهم للقيم المغلوطة السائدة، رافضين، مثلَه، الخضوع، أو الغرق في الصمت المتواطئ مع الفساد.
هذا بالإضافة إلى مزجه موسيقى "الجاز" بالمقامات الشرقيَّة، ما ألهم عددًا من الموسيقيِّين الشباب على امتداد العالم العربيِّ، حيث يُعَدُّ ألبومه "هدوء نسبيّ" ( 1985) أنموذجًا للحداثة المتجذِّرة بعيدًا عن التقليد. أمَّا مسرحيَّاته لاسيَّما مسرحيتَا "شي فاشل" (1983)، "وفيلم أميركيّ طويل" (1980)، فقد تحوَّلت بعض مشهديَّاتها إلى ما يشبه مسرح الظِّلِّ الثقافيِّ يتداولها الطلَّاب والشبَّان متأثِّرين بتصريحاتها، وبالإيحاءات الدالَّة في حواراتها.
لذلك تمكَّن هذا الفنَّان، بعد سنوات من العمل ومن الإنتاج، من أن يصير ذاكرة المكان/ الوطن، وتاريخه المحلِّيّ، والهامش الذي قويَ على المركز، عبر حضوره النغميِّ الموسيقيِّ، وبالكلمة الساخرة العابقة بالمرارة المتهكِّمة، محقِّقًا بذلك هويَّة فنيَّة "عابرة للحدود" لم يستطع أحدٌ منافسته عليها، مؤمنًا إيمان فيودور دوستويفسكي Fyodor Dostoevsky[3] بأنَّ الجمال الذي يبدعه سينقذ العالم، أو ربَّما سينقذه هو من براثن العالم الذي رآه بقلبه، لا بعينيه فحسب، وكأنَّما الفنُّ كان يمسح عن روحه غبار الحياة اليوميَّة، مغذِّيًا أحلامه وعواطفه، ومقدرته على التخيُّل والتعبير، محفِّزًا بذلك أحلام الشباب في زمن الصمت والانهزام، في عالمٍ تكاثرت فيه الضوضاء، وقلَّ فيه الصدق، ليعيد، من خلاله، إلى روحه وإلى أرواحهم توازنها، ويعلِّمها رؤيةَ ما لا يُرى، ومقاومة المبتذل والسقوط في العاديَّة والرتابة، ومناوأة التحدِّيات المجتمعيَّة المجحفة كالتهميش، والبطالة، وسلب الحقوق، وفرض الإملاءات.
لقد استطاع زياد الرحباني، برهافته وعبقريَّته وجرأته التي لامست العبثيَّة في كثير من الأحيان، من تجاوز كونه فنَّانًا متمرِّدًا ليصير حالة فكريَّة وفنيَّة ألهمت شبَّانًا وفنَّانين كثرًا طرائقَ شتَّى في التعبير، وفي القول، محفِّزًا الحسَّ الناقد لديهم، على البحث عن الحقيقة وسط الضباب السياسيِّ والاجتماعيِّ الذي غلَّف الزمان والمكان من حولهم، مجترِحًا بذلك لنفسه هويَّة فنيَّة متفرِّدة ستثبت طويلًا في وجدان الجيل الحاليِّ، كما في وجدان من سيليه من أجيال.
الدكتورة هدى عيد: باحثة متخصِّصة في النقد الأدبيِّ الحديث، وأستاذة مساعدة في جامعة الجنان - صيدا. نالت شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلاميَّة في لبنان عن أطروحتها تحوُّلات الرواية العربيَّة: الشخصيَّات، الفضاء، المنظور. دراسة في نماذج مختارة من الروايات العربيَّة (2002-2016)، مريم الحكايا/علويَّة صبح - الفراشة/ محمَّد الأشعري - يا مريم/ سنان أنطون - الموت عمل شاقٌّ/ خالد خليفة: نماذج. لها تسعُ روايات، وبعض الإسهامات القصصيَّة. حائزة جائزة مؤسَّسة الحريريّ للتنمية البشريَّة المستدامة عن روايتها حبٌّ في زمن الغفلة، وجائزة المطران الأب سليم غزال للسلم والحوار الوطنيِّ اللبنانيّ، عن أعمالها الروائيّة.
[1] "فنسنت فان غوغ Vincent Van Gogh (1853-1890): أحد أبرز رسَّامي هولندا الانطباعيِّين. تتضمَّن رسومه قطعًا شهيرة هي الأغلى سعرًا في العالم"،
https://www.aljazeera.net/science
[2] "غوستاف فلوبير Gustave Flaubert (1821- 1880): روائيٌّ فرنسيٌّ، درس الحقوق، لكنَّه انصرف إلى التأليف الأدبيِّ، صاحب رواية مدام بوفاري 1857"،
https://www.aljazeera.net/science
[3] "فيودور دوستويفسكي Fyodor Dostoevsky (1821-1881): أديب روائيٌّ روسيٌّ ولد في موسكو. كتب روايته الأولى في سنِّ الـخامسة والعشرين، وترجمت أعماله لأكثر من 170 لغة. سُجن وصدر في حقِّه حكم بالإعدام، لكنَّه ألغي في اللحظة الأخيرة. توفِّي في سانت بطرسبرغ"،
https://www.aljazeera.net/encyclopedia
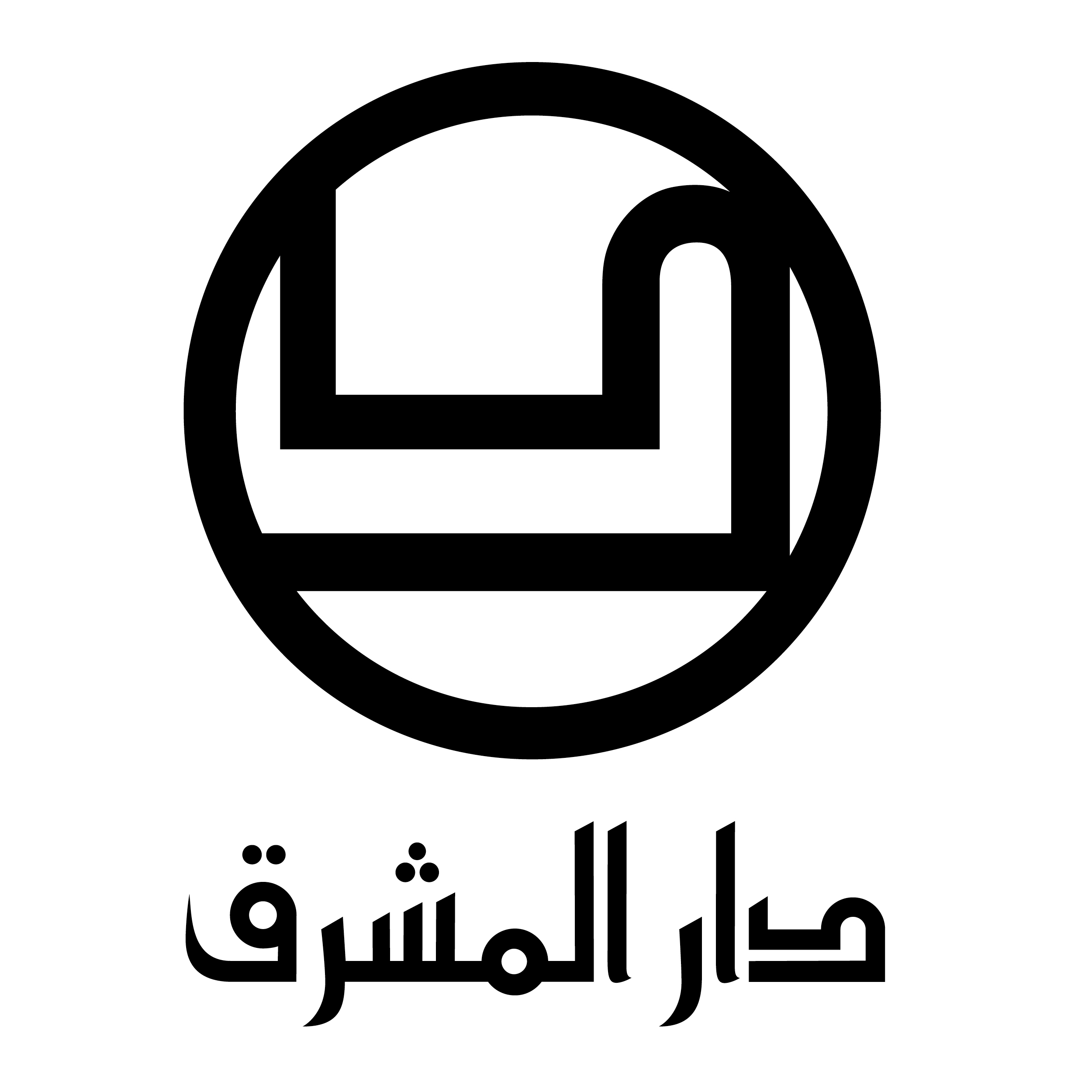

تعليقات 0 تعليق